تربية المجتمع الإسلامي على ثقافة القوة والمقاومة والعزة
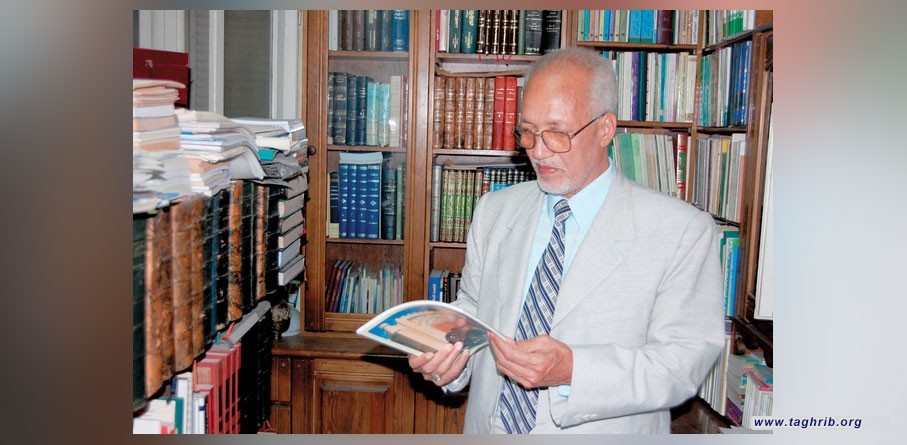
تربية المجتمع الإسلامي على ثقافة القوة والمقاومة والعزة
أ.د. أحمد عبد الرحيم السايح
استاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر - مصر
بسم الله الرحمن الرحيم
الدارس لمسيرة التاريخ الإسلامي، يلاحظ: أن الخصومة ضد الدين الإسلامي، بدأت منذ بدأ الدين نفسه. وأخذت الخصومة تزداد شدة وعنفا، ويزداد الخصوم المناوئون للدين بغيا وعدوانا، وظلما وطغيانا. كلما ازداد هذا الدين اتساعا وانتشارا..
فلم يكن بد من أن يعتمد الإسلام طريق الجهاد في سبيل الله -عز وجل- وسيلة لرد البغي والعدوان وسبلا لقمع الظلم والطغيان.. لكي تنزاح العوائق من طريقه، فيظل سائرا فياضا، ينشر العدل، والمساواة، ويفشي الأمن، والاطمئنان، ويرحم المحتاجين، ويكفكف الطغيان..
ولقد أقبل المسلمون على هذا الميدان الشريف - ميدان الجهاد في سبيل الله- إقبالا عظيما. كان كل منهم يعتبر شرفا أن يشترك في قتال أعداء الله.
أعداء الحق الذين يخاصمون الإسلام، ويجردون السيف في وجهه. ويقفون حجر عثرة في سبيل امتداده ونشره..
وكان لسان حال كل منهم قول القائل:
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع
لقد كانت العقيدة الإسلامية في حياة المسلمين، هي النافذة التي يطلون منها على العالم بمن وما فيه.. كما كانت العقيدة ذاتها هي المنظار، الذي ترى بواسطته كافة حقائق العلوم والوجود..
وإن مصدر الفاعلية في العقيدة الإسلامية، كان الأساس الفكري والروحي لإطار عملي تطبيقي، يحدد لإنسان العقيدة "المؤمن" بها "والمؤتمن" على سيادتها. أسلوب تعامله مع الأغيار..
وقد علمنا التاريخ والمنطق: أن الموقف العملي لا يكون عمليا ما لم يحكم بحركة الإنسان وتواجداته، وإلا فهو موقف نظري ليس مكانه ساحات الجهد والجهاد، والمخمصة والممارسة والمعاناة.
لقد كان المسلمون يقبلون على الجهاد في سبيل الله. لوجه الله، وبإخلاص منقطع النظير..
وكان المجاهدون يقبلون على القتال في سبيل الله ثابتين، صابرين على ما يصيبهم، قد تركوا وراءهم الدنيا بلهوها ولعبها، وخرجوا إلى الميدان يحملون أرواحهم على أكفهم مجاهدين تتوق قلوبهم إلى الشهادة..
وكانوا يحرصون على الموت في ساحة الجهاد أكثر من حرصهم على الحياة، ويتمنون الاستشهاد تمني الظامئ للماء..
والإسلام يرمي من وراء مبادئه، وتعاليمه، وإرشاداته، ونظمه، إلى إيجاد أمة قوية متماسكة، عزيزة الجانب، موفورة الكرامة، يتساوى أفرادها في الحقوق والواجبات، وتتعاون على ما يجلب لها الخير، ويدفع عنها الشر، وتتضافر جهودها على إعلاء كلمة الله، لنتمكن من إقامة دولة الحق في الأرض.
ومن أجل ذلك كان الجهاد في الإسلام. لإعلاء كلمة الحق، ومطاردة الباطل وكان على الأمة أن تعد ما تستطيع من قوة، لتصبح شديدة الشوكة، قوية البأس، مرهوبة الجانب، قادرة على الدفاع عن نفسها، ومواجهة كل عدو يعتدي عليها، أو يقف في سبيل الإسلام..
حقا: إن الإسلام حين يضطر إلى القتال، فإنما يمارس أشرف أنواع القتال. ذلك الذي لم ولن تعرف الدنيا له عدلا، ولا نظيرا من قريب أو بعيد. من حيث أسبابه وبواعثه، وأهدافه وغاياته، وملابساته، وظروفه، وتقاليده، وآدابه.
ذلك أن أسبابه جميعها تلتقي عند خط الدفاع، ودرء العدوان، ورد الهجوم، واسترداد الحق السليب، والكرامة المهيضة، والأمل الشريد، واقتلاع جذور الظلم، وانكسار حدته، وانحسار موجته.
ولولا أن يكون هذا من أسباب الجهاد في الإسلام، وبواعث مشروعيته لاعتلت المفاهيم، واختلت الموازين، واضطرب أمر الحياة، ولخلا وجهها من الحق وجنده..
وتلتقي بواعث الجهاد أيضا: عند درء الفتنة إذا ذر قرنها، واستيقظ شرها وتطاير شررها.. وذلك لأن طاقات النفس محدودة، وقدراتها تحت مطارق الفتن، وصروف الهوان قاصرة. إن القتال حينئذ حبل إنقاذ ينقذ المحطومين، ويمنع المتآمرين من التوسع والمزيد.
والإسلام حين يأمر بالقتال وفي نطاق الضرورة، والضرورة القصوى، يقاتل في معركة شرف، وقضية نبل، وليس في الوجود كله أشرف منها ولا أنبل.
والقتال في الإسلام أكبر الفضائل الإسلامية، لأنه تقديم النفس للموت في سبيل الإسلام. وهو أشق الفضائل احتمالا. والباعث عليه فضيلة.
لأن الباعث إما رد الاعتداء.. ولا يقبل الاعتداء وهو يستطيع دفعه إلا الذليل..
وإما تأمين الدعوة الإسلامية، وفتح الطريق أمامها..
وإذا كان الجهاد فضيلة إنسانية. فلا يصح أن تنتهك حرمة الفضيلة في أثنائها.. والفضيلة الإسلامية واجبة الرعاية، في الحرب والسلم، ورعايتها في الحرب يعلي من قدر من يتمسك بها. إذ هو يتمسك حيث اشتجرت السيوف، ووقعت الحتوف..
لقد كان الأمر بالقتال في الإسلام قائما على القيم الرفيعة. فقد أراد هذا الدين أن يرتفع بالناس من عبادة العباد، إلى عبادة رب العباد..
أراد أن يحطم الطواغيت المادية والمعنوية في الداخل والخارج وأن يجعل الخضوع لله وحده لا يشاركه فيه مشارك، ولا ينازعه فيه منازع. فلم يكن القتال في الإسلام إذن غرضا بذاته، وإنما كان وسيلة لتحقيق هدف سام..
وإذا تأملنا الآيات التي تتحدث عن القتال في كتاب الله، وجدنا أنها بثت روحا ومفهومات في غاية السمو والقوة. وذلك لترفع من معنويات الأمة الإسلامية، وتحملها على الجهاد الذي لا يفتر، والثبات في سبيل الله. وهي بذلك تسبر أغوار النفس الإنسانية لتعالج ما فيها، وتحملها على تجدد الطاقات، وشحذ الهمم..
إن القتال في سبيل الله ضرورة لا غاية، ووسيلة أخيرة، يلجأ إليها الإسلام إن أعوزته الوسائل.. ومعروف لدى الملتزمين: أن الضرورة تقدر بقدرها، ولا تمارس إلا متعينة وفي أخص الظروف وأمسها وأقساها.
والإسلام لا يقبل من المسلمين أن يقاتلوا من هادنهم، أو سالمهم، أو عاهدهم أو وادعهم.. إنما يأمر بقتال من قاتلهم، وناوئهم، أو عاداهم وخاصمهم.. دون تحامل من المسلمين أو تحايل أو تربص أو استفزاز..
يقاتل المسلمون في إطار الضرورة الملحة أهل الظلم والطغيان، والجبروت، وأصحاب القهر، والعسف، والتسلط، وذوي الغدر والخيانة، والماردين، وأهل الخسة والتآمر، والضالعين في الخصومة واللجاجة، والمروق والدناءة.
يقاتلهم المسلمون المعتزون بإسلامهم، ويمتشقون الحسام عليهم، ويسلون السيوف في وجوههم.
ما رفعوا في وجه الإسلام عقيرتهم، وناؤوا ظهره بسخائمهم، وكدروا صفوه بأرجاسهم، ووضعوا في ميدان مده السدود والعقبات، وزرعوا في طريق سفينته الجنادل والصخور وصادروا الحريات والكرامة والعقائد، وطمسوا في الإنسان إنسانيته، وعفنوا جو الحياة بوثنهم وعفنهم في مجالات السلوك والعقيدة، والخلق والحكم، والتشريع.
ومن الثابت لدى الباحثين: أن الصراع بين الأحياء من طبيعة الحياة.. وقوى الشر، والإلحاد، تعمل دون هوادة، والمعركة مستمرة، بين الخير والشر والصراع قائم بين قوى الإيمان وقوى الطغيان، والشر جامح، والباطل مسلح.
ومن هنا ولهذا: حرص الإسلام على أن يكون المسلمون على استعداد لمواجهة الباطل، وقوى الإلحاد، والإضلال والطغيان. مهما تكن التضحيات في النفس والأهل والمال.
والمواجهة بين الحق والباطل ضرورة مؤكدة. وقد أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) سورة الحج [آية 40]..
وحتمية المواجهة تستدعي ضرورة الاستعداد.. وليس شرطا أن ينتظر المسلمون حتى يروا إمارات الشر والعدوان..
إنما على المسلمين أن يدركوا طبيعة الحياة، من واقع الناس، فيبذلوا قصارى الجهد في إعداد القوة. وإلى هذا يوجه القرآن الكريم المؤمنين بقوله: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ) سورة الأنفال [آية 60].
فالاستعداد بما في الطوق هو فريضة الجهاد في الإسلام. والقرآن الكريم يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وأسبابها..
ومن إعداد القوة: التمسك بالعقيدة التي اشتمل عليها القرآن الكريم، وأرسى قواعدها وأصولها الرسول الأمين محمد صلوات الله وسلامه عليه..
والعقيدة الإسلامية تبعث في روح المؤمن القوة الدافعة إلى كل خير، وتملأ القلب بالثبات واليقين. وفوق هذا فهي أعطف شئ على الإنسان، وأحنى آس عليه يعتصم بها الإنسان، ويستسهل بها صعوبات الحياة..
إنها عقيدة التوحيد والتنزيه. تحمل للنفس الإنسانية روحا من الإباء لا يقدر على الإتيان بمثلها غيرها.. عقيدة تحبب في الحياة السليمة، وتبث في الأفئدة حرارة الشم والحمية..
والآية الكريمة: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ) تشتمل فيما تشمل من قوى على قوة العقيدة. لأن الوسائل المادية وحدها ليست هي التي تفصل في المعارك الحربية. وكثيرا ما تنفلت موازين أعصاب المحاربين. فيولون هاربين، ولا يوجد ما يثبت الأعصاب ويقويها كالعقيدة الإسلامية التي تصل القلوب بالله سبحانه وتعالى، وتصل قوة المجاهدين بالقوة الكبرى التي لا تغلب..
والله يأمر المؤمنين بالاستعداد لدفع العدوان، وحفظ الأنفس والعقيدة والبلاد، والحق، والفضيلة. ويكون ذلك بأمرين:
الأمر الأول: إعداد المستطاع من القوة ويختلف باختلاف الزمان والمكان.
الأمر الثاني: المرابطة في ثغور البلاد لحراسة الحدود. إذ هي مداخل الأعداء ومواضع مهاجمتهم.
والحكمة في هذا أن يكون للأمة الإسلامية جند دائم الاستعداد، مستعد للدفاع عنها إذا فاجأها العدو.
والأعداء: أعداء العقيدة والحق. إذا علموا استعداد المسلمين وتأهبهم للجهاد خافوا وتهيبوا، وإلى هذا يشير أبو تمام:
وأخافكم كي تغمدوا أسيافكم إن الدم المغير يحرسه الدم
وهذا الخوف يفيد المسلمين من وجوه:
أولا: يجعل أعداء المسلمين لا يعينون عدوا آخر عليهم.
ثانيا: يجعل الأعداء يؤدون الالتزامات المطلوبة من مراعاة آداب، ومعاهدات، واستيراد، وتصدير، واستثمار.
ثالثا: ربما حض ذلك على دخول كثير في الإسلام.
وإعداد القوة في الإسلام والتي جاء بها الأمر بها. ليس المقصود بها إعداد قوة مماثلة لقوة الأعداء. لأن فريضة الجهاد في الإسلام لا تنتظر حتى يتم إعداد قوة مماثلة لقوة العدو. لأن ذلك قد يطول..
ولو انتظر المسلمون في معركة بدر الكبرى حتى تتكافأ قوتهم وقوة عدوهم، ما قامت لهم قائمة.. إنما القلة المؤمنة بالله، والمعتزة بعقيدتها اعتزازا يفوق كل اعتبار. استعدت بقدر ما استطاعت. ثم خاضت المعركة، فكان فيها الفرقان..
والآية الكريمة التي أمرت بإعداد القوة. فيها كلمة "ترهبون" وقد جاءت بصيغة الفعل المضارع. وهى تشير إلى الغرض من إعداد القوة، وهو إلقاء الرهبة في قلوب أعداء الله، وأعداء المسلمين المعلومين منهم والمجهولين، والمتخفين. وكم للمسلمين والإسلام من أعداء.
فالأحزاب الهدامة، والأفكار الإلحادية، ودول الإستكبار والاستعمار، والصهيونية كلها تشكل حربا خطيرة ضد المسلمين والإسلام..
وهؤلاء - ولا شك - ترهبهم قوة الإسلام في نفوس المسلمين، وقوة المسلمين في المجتمعات الإسلامية، ولو لم تمتد إليهم.
والآية الكريمة: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ) على إيجازها الدقيق، واختصارها المحكم، قد جمعت أنواع الإعداد للجيوش التي تتلاءم مع كل عصر، وزمن. كالإعداد المادي، والإداري، والفني، والمالي، والتخطيط، والدراسة الموضوعية - لمقتضيات الأحوال.. والإعداد بكل ما تشمله كلمة إعداد من معنى ومفهوم ومدلول..
وإن أي تصور يجنح إلى قيام الحياة في المجتمعات الإسلامية دون هذا الاستعداد وهم يؤدي إلى الضعف، والذوبان، والانسلاخ.. والله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكون حملة الإسلام، وحماة الدعوة الإسلامية من الجامدين الكسالى الذين ينتظرون النصر لمجرد أنه مسلمون.
والأمة الإسلامية في أشد الحاجة إلى استيقاظ كل الخلايا فيها، واحتشاد كل القوى وتوفر كل استعداد، وتجميع كل الطاقات، كي يتم النمو، ويكمل البناء. لأن تحركات الأعداء لا تتوقف، وتكالب الأعداء يزداد شراسة وسعارا..
ولا جرم فإن الحق الأعزل ضائع. ولابد للحق من رجال وقوة. لا لتذود عن الحق فحسب. بل لتطاول الباطل..
ولكن أي قوة تلك التي يمتدحها الإسلام، ويطالب المسلمين أن يتسلحوا بها؟ إنها ولا شك: ليست القوة الباغية الظالمة، إذ رسالة الإسلام حرب على البغي والظلم والعدوان..
إذن لهي بالتأكيد: القوة الواقفة بالمرصاد لأهل الإلحاد والمادية والفساد والتخريب.
والقوة التي يمتدحها الإسلام: قوة الجسم، وقوة العقل، وقوة الروح، وقوة الخلق، وقوة العزيمة، وقوة الإرادة.
ولقد كان لأجدادنا المسلمين الأوائل فضل التأسيس للحضارة الإنسانية، وفضل شق الطريق للفتوحات الإسلامية في ميادين العلم، والاجتماع، والاقتصاد، والطب، والزراعة والصناعة، وغير ذلك من فنون جاءت ثمرة من ثمرات الجهاد في الإسلام.
وقد عاش المسلمون عصورهم أعزاء أقوياء أغنياء. كل ذلك بفضل عامل الاستعداد والإعداد، الذي لم يكن مجتمع من المجتمعات الإسلامية يخلو من تشجيعه..
وقد كان للمسلمين الأولين تاريخ عظيم، سطروه بدماء الشهداء والمجاهدين ولا تزال صفحات التاريخ الإسلامي لألاءة تزخر بكل أحداث العز. فقد برز في الإسلام رجال تفوقوا حتى أنفسهم، فأظهروا شجاعة أصيلة وشهامة نبيلة، وبطولة فذة، وفدائية نادرة. هؤلاء المسلمون رباهم الإسلام على كتاب الله، فتخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه، وأخذوا أنفسهم بشرائعه وأحكامه، واغترفوا من نبعه الطاهر.
وما ظنك بمن يكن كتابه القرآن الكريم، ورسوله محمد صلي الله عليه وعلي آله وسلم، ومدرسته الإسلام الحنيف.. لابد أن يكون في قمة القمم السامية خلقا وفعالا، وحركة وجهادا.
وقد كان هؤلاء كذلك. فبأعمال هؤلاء الأبطال سقط البغي والطغيان، واندك صرح الظلم والجبروت وانزاحت العوائق من طريق الدعوة الإسلامية، ودخل الناس في دين الله أفواجا،ووطدت دعائم الأمة، وقويت شوكتها، وارتفعت خفاقة..
ولولا بطولة المسلمين لظلت الجاهلية والقوانين الهدامة تنيخ على صدر البشرية بكلكلها، وتضغط بكل ما لديها من عهر ومجون واستهتار.
ولولا فدائية المسلمين لبقيت شعوب العالم ترتكس في هوان، وتتردى من ذل إلى ذل، ومن جهالة إلى جهالة..
ولولا أن باع المسلمون الأوائل أنفسهم في سبيل الله لتخلفت مواكب الحضارة الإنسانية.
وإن الأمة الإسلامية تملك من الطاقات البشرية، والإمكانيات المادية، والمواقع الاستراتيجية، ما يمكنها من أن تكون أعظم قوة في الأرض. لا لتضرب في عتو وتجبر ولكن لتقيم العدل بين الناس وتنشر الأمن، والسلام، والاطمئنان، وترد كيد الكائدين.
وهناك عنصر لا يتوفر لأمة كما يتوفر للأمة الإسلامية وهو رابطة الأخوة الإسلامية القائمة على أساس الإيمان بالله وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام..
وأخوة المسلمين على اختلاف أقطارهم، وأعراقهم، وألوانهم، ومصالحهم الدنيوية ليست من نوع الأخوة الوطنية، ولا من نوع العصبية، ولا من نوع الرابطة الاجتماعية التي تشد الأواصر بين الخلطاء والشركاء، حول مصالحهم الاقتصادية والمعاشية..
ولكنها أخوة من صميم العقيدة. لا يتم إسلام المسلم، ولا يتحقق إيمانه إلا إذا استقرت في قلبه استقرارا وجدانيا، ينسى معه كل مصلحة شعوبية، أو مذهبية، أو عصبية أو إقليمية، أو عائلية أو شخصية، أو اقتصادية، أو معاشية، حتى يجعل هذه المصالح كلها غير ذات بال إذا تعارضت مع تلك الأخوة الإسلامية.
إن الأخوة الإسلامية الصادقة تستطيع أن تقضي على الفتن، ومن يهددون الأمن ويقلقون السلم.
والأخوة الإسلامية حرب لمن يدسون الدسائس، ويزرعون الوقيعة، ويبثون الخدع وينشرون الأراجيف، وينفثون السموم، ويروجون لأساليب الهدم والدمار من المذبذبين وذوي الضمائر الفاسدة، والذمم الخربة، وأهل النكت والخيانة.
والجندية في الإسلام تعمل على الغوث، والنجدة، والشهامة، ورعاية الحقوق وتعهد الذمم، وتوطيد العلائق، وتوثيق الصلات بين أهل الإسلام، ومشاركة المسلمين في السراء والضراء..
ففي قلب كل مؤمن زرع فيه الإيمان. مركز استشعار تسجل ذبذباته ومؤشراته خواطر الحق، وحاجات المسلمين، وتهتز أجهزته ملبية على أوسع مدى وأسرع وقت بالغوث والتعاون.
وإذا كانت الأمم تتكاتف لتكبر في قوى ومعسكرات، ومناطق نفوذ. فأولى بالمسلمين أن يجتمعوا على الإيمان، وأن يتناصروا على الحق، والخير، والعدل، والإنصاف ليكونوا القوة القادرة على استرداد الحق، والكرامة.
وأمتنا الإسلامية تملك من أسباب التقدم والريادة ما يؤهلها. لأن تكون خير أمة أخرجت للناس، ومن ذلك: أن الله سبحانه وتعالى حياها بأعظم النعم، إذ تتربع على كنوز ثمينة، وتربض على ثروات معدنية هائلة، وتملك من حقول البترول أجداها نفعا، وأكثرها سخاء وثراء، وأقواها تدفقا وعطاء..
كما أنها تمتلك من شواطئ البحار والأنهار، والممرات، والطرق البرية، والبحرية، والجوية ما يجعلها في مركز القيادة، ويمكنها من الإشراف والتحرك الفعال..
وكان من فضل الله على الأمة الإسلامية أن جعلها في مناطق الثقل العالمي لتؤدي دورها المؤثر في صدق وفاعلية..
وما علينا لنبلغ ما نريد إلا أن نتمسك بالإيمان الكامل، واليقين الثابت الذي - لا يتزعزع أمام أعاصير النكبات والبلايا، مهما كانت قوية وشديدة.. ونعمل في سعي متواصل لإقرار مبادئ الحق والعدل، والانتصار لدين الله عز وجل ونخلص لوجه الله فلا نبغي بأعمالنا شهرة ولا جاها.
والقتال في الإسلام والجهاد في سبيل الله مجرد من كل غاية أرضية، ومن كل دافع شخصي، ليتمخض خالصا لله، لتحقيق كلمة الله، ابتغاء رضوان الله.
فإعداد القوة المادية والمعنوية، أمر لابد منه للمسلمين. والقوة المعنوية في الإسلام لها تأثيرها وأثرها والجهاد له إحدى الحسنيين.
ويهيئ القرآن الكريم نفوس المسلمين لهذا المعنى، فيورده بأسلوب التشويق حتى يكون شعار المؤمنين في الحياة.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُّلُّكمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّن اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) سورة الصف [آية 10-13]
فالإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بمنزلة التجارة يربح فيها المؤمنون رضاء الله، ونيل جنته. وذلك خير من أي تجارة أخرى.
وثمة خصلة أخرى يحبها المؤمنون في الدنيا مع ثواب الآخرة، وهي النصر على الأعداء. وهكذا تضيف آيات سورة الصف إلى الفوز بالجنة ثمرات يحبها المؤمنون من وراء هذه التجارة مع الله وهي النصر، والفتح في الدنيا.
ذلك أن المجاهد حين يقاتل فيقتل أو يقتل فإنما يصنع الحياة الحرة الكريمة. قال تعالى:
(وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) سورة آل عمران [آية 169] وهذا يعني: أن أسلوب الجهاد ضرورة من ضرورات الحياة الكريمة، وأي تقصير في التهيؤ والاستعداد والجندية. يعرض الأمة لأخطار كثيرة، ويفقدها مميزاتها في الحياة. والمؤمن في عملية الجهاد والتجنيد والاستعداد للدفاع.
كأنه عقد مع الله سبحانه وتعالى صفقة، أعطى فيها وبها لله كل شيء، ليفوز بجنة الله التي أعدها للمجاهدين. قال تعالى: (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) سورة التوبة [آية 111] .
ومن المسلم به: أن الجهاد المنشود في الإسلام لإعلاء كلمة الله، وحماية الأوطان وحماية المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يجعل دعوة الإسلام جهيرة في مسامع الدنيا، ويبدي لكافة الناس: أن شريعة القرآن الكريم، شريعة الاعتزاز بنفسها وتعاليمها وأهدافها، شريعة نهوض على دعائم الحق، وطموح وثاب.
وليست شريعة هوان وانكماش، وتخلف كما يحاول تصويرها بذلك أولئك الجهلاء أو المغرضون المتجاهلون([1]).
والباحثون: يدركون أن أوروبا اكتشفت الفكر الإسلامي في مرحلتين من مراحل تاريخها: فكانت مرحلة القرون الوسطى، قبل وبعد "توماس الإكويني"([2])، تريد اكتشاف هذا الفكر، وترجمته من أجل إثراء ثقافتها بالطريقة التي أتاحت لها فعلا تلك الخطوات التي هدتها إلى حركة النهضة منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي، وفي المرحلة العصرية والاستعمارية، فإنها تكتشف الفكر الإسلامي مرة أخرى.
لا من أجل تعديل ثقافي، بل من أجل تعديل سياسي، لوضع خططها السياسية، مطابقة لما تقتضيه الأوضاع في البلاد الإسلامية من ناحية أخرى، ولتسيير هذه الأوضاع طبق ما تقتضيه السياسات في البلاد الإسلامية([3]).
ويذكر المؤرخون: أن الجيوش الأوروبية الصليبية لما هاجمت بلاد الإسلام كانت مدفوعة إلى ذلك بدافعين:
الدافع الأول: دافع الدين والعصبية العمياء التي أثارها رجال الكنيسة في شعوب أوروبا، مفترين على المسلمين أبشع الافتراءات، محرضين النصارى أشد تحريض على تخليص مهد المسيح من أيدي الكفار - أي المسلمين - فكانت جمهرة المقاتلين، من جيوش الصليبيين من هؤلاء الذين أخرجتهم العصبية الدينية من ديارهم عن حسن نية، وقوة عقيدة، إلى حيث يلاقون الموت، والقتل، والتشريد، حملة بعد حملة، وجيشا بعد جيش.
والدافع الثاني: دافع سياسي استعماري، فلقد سمع ملوك أوروبا بما تتمتع به بلاد المسلمين من حضارة وثروات، فجاءوا يقودون جيوشهم باسم المسيح، وما في نفوسهم إلا الرغبة في الاستعمار والفتح، وشاء الله أن ترتد الحملات الصليبية مدحورة مهزومة([4]).
ويكاد يكون معروفا، أن أوروبا شنت ثمان حملات صليبية على الشرق الإسلامي وقد بدأت الحروب الصليبية منذ منتصف القرن الحادي عشر، واستمرت حتى نهاية القرن الثالث عشر، أي ما يقرب من مائتين وخمسة وعشرين عاما في ثماني حملات من الحملات المدججة بالعدد والمعدات.
ويصف كاهن مدينة لوبوي: ريموند واجيل سلوك الصليبيين حينما دخلوا على القدس، فيقول: "حدث ما هو عجيب بين العرب عندما استولى قومنا على أسوار القدس وبروجها، فقطعت رؤوس بعضهم، فكان أقل ما أصابهم، وبقرت بطون بعضهم، فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار، وحرق بعضهم في النار، فكان ذلك بعد عذاب طويل.
وكان لا يرى في القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم، فلا يمر المرء إلا على جثث قتلاهم، ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض ما نالوه"([5]).
وروى الكاهن نفسه خبر ذبح عشرة آلاف مسلم في مسجد ويقول في هذا: "لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان، فكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك، وكانت الأيدي والأذرع المبتورة تسبح وكأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة عنها. فإذا ما اتصل ذراع بجسم لم يعرف أصله، وكان الجنود الذين أحدثوا تلك الملحمة، لا يطيقون رائحة البخار المنبعثة من ذلك إلا بمشقة"([6]).
ويذكر التاريخ: أن الحملة الصليبية عند دخولها بيت المقدس في 15 مايو عام 1099م قد ذبحت أكثر من سبعين ألف مسلم، حتى سبحت الخيل إلى صدورها في الدماء، وفي أنطاكية قتلوا أكثر من مائة ألف مسلم.
فالأمر خطير. إنه حقد الشر على الحق، والرذيلة على الفضيلة، وعداوة الشرك للتوحيد، وخصومة الضلال للهدى([7]).
وقد صمدت الأمة الإسلامية في وجه هذه الحروب الوحشية التي سلبت ونهبت، وقتلت وفتكت.
وبعد مضي أكثر من قرنين من حروب دامية، اشتد وطيسها بين كتائب الإيمان، وبين جحافل الشر، ارتدت الحروب الصليبية، وقد باءت هذه الحملات بالإخفاق والهزيمة، فالقديس "لويس التاسع" قائد الحملة الصليبية الثامنة، وملك فرنسا، وقع أسيرا في مدينة "المنصورة" في مصر، ثم خلص من الأسر بفدية.
ولما عاد إلى فرنسا أيقن أن قوة الحديد والنار لا تجدي نفعا مع المسلمين الذين يملكون عقيدة راسخة، تدفعهم إلى الجهاد، وتحضهم على التضحية بالنفس، وبكل غال.
إذن: لابد من تغيير المنهج والسبيل، فكانت توصياته: أن يهتم أتباعه بتغيير فكر المسلمين، والتشكيك في عقيدتهم وشريعتهم، وذلك بعد دراستهم للإسلام لهذا الغرض، وهكذا تحولت المعركة من ميدان الحديد والنار إلى ميدان الفكر([8])، لأن القضاء على الإسلام أو تحويل المسلمين عن دينهم، لا يمكن أن يأتي عن طريق القوة المادية، والغزو المسلح.
ولقد بدأت حركة "الغزو الفكري" من منطلق ضرب المسلمين عن طريق الكلمة بعد هزيمة الحروب الصليبية - كما وجههم "لويس التاسع" - والعمل على ترجمة القرآن، والسنة، وعلوم المسلمين، للبحث عن الثغرات التي يدخلون منها إلى إثارة الشبهات.
وقد أعلنوا صراحة: أن الإسلام هو عدوهم الأول، وأن أكبر غاية لهم هي ضرب وهدم قواعده" ([9]).
لقد فشلت الحروب الصليبية من الوجهة الحربية.. لكن بقي الغزو الفكري ينفث سمومه، ويثير الشكوك، وبقيت النزعة الصليبية تتوارى خلف ستار من الدبلوماسية، والرياء السياسي، تحرك ما تريد تحريكه، وتقف خلف الغزو الفكري بكل ما لها من قوة، وعلم...
ولا شك أن العداء الصليبي للإسلام هو الدافع الأساسي والأصيل "للغزو الفكري" الذي تسلط على مجتمعات الأمة الإسلامية، ونجد أن هذا العداء أخذ "شكل السعار الوبائي" لدى الأمم الغربية خاصة الولايات الأمريكية "الصليبية" فأخذوا مستميتين يوزعون السموم، ذات اليمين وذات الشمال، ويفترون الأكاذيب، ويطمسون الحقائق، ويدبرون المكائد، ويتصيدون السقطات، ثم يدخلون في روع أنفسهم، وبني جلدتهم أنهم أرقى عنصرا وأفضل عقلا، وأفلح دينا، وأنهم أوصياء على البشرية، وسادة الإنسانية، وهداتها، ومرشدوها([10]).
وقال "وليم غيفورد بلغراف" الإنجليزي المسمى بالحرباء الكلمة المشهورة التي يلخص فيها عداء الغربيين للإسلام: "متى توارى القرآن، ومدينة مكة، عن بلاد العرب يمكننا أن نرى العربي، يندرج في سبيل الحضارة، التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه"([11]).
وجلادستون رئيس وزراء بريطانيا يقول: "ما دام القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، ولا أن تكون هي نفسها في أمان"([12]).
ويرى غاردنر: "أن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا"([13]).
ويوضح هذا العداء، ويذكر بعض أسبابه المستشرق "بيكر" فيقول: "إن هناك عداء من النصرانية للإسلام، بسبب أن الإسلام عندما انتشر في العصور الوسطى أقام سدا منيعا في وجه الاستعمار، وانتشار النصرانية، ثم امتد إلى البلاد التي كانت خاضعة لصولجانها"([14]).
ويقول في هذا المعنى "لورانس براون": "إن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام، وفي قدرته على التوسع والإخضاع، وفي حيويته، إنه الجدار الوحيد فلي وجه الاستعمار الغربي"([15]).
ثم بين "لورانس براون" أن خطر المسلمين هو الخطر العالمي الوحيد في هذا العصر، الذي يجب أن تجتمع له القوى، وتجيش له الجيوش، وتلتفت إليه الأنظار، فيقول حاكيا آراء المبشرين: "إن القضية الإسلامية تختلف عن القضية اليهودية، إن المسلمين يختلفون عن اليهود في دينهم، إنه دين دعوة، إن الإسلام ينتشر بين النصارى أنفسهم، وبين غير النصارى.
ثم إن المسلمين كان لهم كفاح طويل في أوروبا - كما يراه المبشرون - وهو أن المسلمين لم يكونوا يوما ما أقلية موطوءة بالأقدام".
ثم يقول: "إننا من أجل ذلك نرى المبشرين ينصرون اليهود على المسلمين في فلسطين، لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي والخطر الأصفر باليابان وتزعمها على الصين وبالخطر البلشفي، إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق (لم نجده ولم يتحقق) كما تخيلناه، إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم([16])، عدونا الألد، ثم رأينا البلاشفة حلفاء لنا، أما الشعوب الصفر، فإن هناك دولا ديمقراطية كبيرة تتكفل بمقاومتها، ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام"([17]).
ولقد اشترك الاستعمار الغربي، والجهد التبشيري، والحقد الصليبي، في حرب المسلمين، وتشتيت تراثهم، ونهب ديارهم، بحيث أصبح يخيم عليهم كسحابة سوداء من البغضاء والكراهية، يتمثل هذا فيما حدث في عام 1918م عندما دخل اللورد اللنبي القدس وأعلن: "الآن انتهت الحروب الصليبية".
كان هذا القائد يعبر عن الروح الغربية، الروح الصليبية، التي ظلت متوهجة في أعماقهم طوال تلك الحقب.
وبنفس الحقد الذي صدر عن الجنرال الإنجليزي اللنبي، كان مسلك الجنرال الفرنسي "غورو" قائد الجيش الفرنسي في دمشق حين ذهب إلى قبر صلاح الدين، بعد أن جاء راكبا سيارة مكشوفة، وترجل إلى القبر، وقال قولته المشهورة: "نحن هنا يا صلاح الدين".
وفي اليوم التالي عمل الشئ نفسه في حمص، حيث ذهب إلى قبر "خالد بن الوليد" t وقال: "نحن هنا يا خالد"([18]).
هذا الحقد والضغن، والمقت، كان سببا قويا في الإغارة على المسلمين بشتى الأساليب، والطرق، والأشكال، والألوان، وما زالت تلك الموجة، تعلو، وتشتد، وتمتد، ثقافيا وفكريا، لتخريب قواعد الإسلام، والأخلاق الإسلامية، وإشاعة الأفكار والتيارات الهدامة([19])، وشغل الأمة الإسلامية، بكل ما هو هامشي في حياتها، حتى لا تدرك اليقظة الواعية، ولا تنتبه إلى ما يحاك حولها.
وإذا كان القتال فى الإسلام ضرورة ووسيلة يلجأ إليها المسلمون حين يون أعداءهم يتكالبون عليهم فإنه من المعروف كذلك، أن الإسلام لم يدخل معركة إلا مضطرا، ولم يخض معركة لم يدع إليها ولم يخضها متشفيا أو متشوقا إلى دماء.
فلا يقاتل الإسلام من هادنه، أو سالمه، أو عاهده، أو أودعه، إنما يقاتل الإسلام من قاتله وناوأه أو عاداه وخاصمه دون تحامل منه أو تحايل أو تربص بخصم أو استفزاز له أو تمن للقائه، أو حب في مواجهته.
يقاتل الإسلام في إطار الضرورة الملحة أهل الظلم والطغيان، والجبروت، وأصحاب القهر، والعسف، والتسلط، وذوي الغدر، والنكث، والخيانة، والقائمين على الخسة والتآمر والضالعين في الخصومة واللجاجة والمروق والدناءة.
يقاتلهم الإسلام، ويمتشق الحسام عليهم، ويسل السيف في وجوههم ما رفعوا في وجهه عقيرتهم.
وناوءوا ظهره بسخائمهم، وكدروا صفوه بأرجاسهم ووضعوا في ميدان مده السدود والعقبات وزرعوا في طريق سفينته الجنادل والصخور وصادروا الحريات والكرامة والعقائد وطمسوا في الإنسان إنسانيته وامتهنوا آدميته.
وعفنوا جو الحياة بوثنهم وعفنهم في مجالات العقيدة والسلوك والخلق وميادين التشريع والسلطان والقانون والحكم.
يقاتل الإسلام هؤلاء. ليخلي الطريق أمام عقيدة التوحيد وتشريع السماء أن يلتزم وقانون العدل أن يتبع ومبادئ الحق أن تحتذى، وقيم الفضيلة أن تنشر، ووازع الإيمان أن يسود، ومظاهر الانحلال والانحراف وشريعة الغاب أن تذوي وأن تموت إلى غير رجعة ليعيش البشر ناعمين بنعمة الحياة التي دونها ما في الوجود من نعم: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً) [سورة المائدة : 3].
إذن فالإسلام حين يقاتل وفي نطاق الضرورة والضرورة القصوى يقاتل في معركة شرف وقضية نبل ليس في الوجود كله أشرف منها ولا أنبل.
لذا لا يفارقه إبان قتاله هذا شرفه ولا نبله ومسلكه في هذا جميعا عدله المطلق وقسطاسه المستقيم وتقواه الواقية الشافية العاصمة القاصمة وذلكم لعمر الحق جوامع الفضل، ومجامع الأدب، وضوابط الحكمة، ومكامن الرفق، وأحكام السلام وخزائن الأمن ومنطلقات الرحمة التي لا تفارق أبدا سيف الإسلام في يده؟ أو في غمده؟
وكم كان لهذه الجوامع من عواقب حميدة ونتائج بارة سجلها التاريخ للإسلام في صحائف الشرف بأحرف من نور بحيث ظلت هذه الآثار الكريمة لصانعيها أوسمة فخار وآيات مجد يشار إليها في مجال السماحة والحرية والإنصاف والسلام بكل الإعزاز والإكبار.
حقا: إن الإسلام حين يضطر إلى القتال فإنما يمارس أشرف أنواع القتال وأنبله ذلكم الذي لم ولن تنصف الدنيا له عدلا ولا نظيرا من قريب أو بعيد من حيث أسبابه وبواعثه وأهدافه وغاياته وملابساته وظروفه وتقاليده وآدابه.
ذلكم أن أسبابه جميعا تلتقي عند خط الدفاع ودرء العدوان ورد الهجوم واسترداد الحق السليب والكرامة المهيضة والأمل الشريد واقتلاع جذور الظلم وكسر حدته وانحسار موجته وعودة أصحاب الحق إلى أرضهم وديارهم وأموالهم التي شردوا منها ومزق شملهم وديست كرامتهم وصودرت حرياتهم وعقيدتهم بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا الله.
ولولا أن يكون هذا من أسباب القتال في الإسلام وبواعث مشروعيته ولولا أن يغري الله به أولياءه لاعتلت المفاهيم واختلت الموازين واضطرب أمر الحياة ولخلا وجهها من الحق وجنده ولخلصت للبعض حربه ولآذن الحال - والشأن هكذا - بزوال الكون وانتهاء الوجود "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله"([20]).
وتلتقي أيضا بواعثه عند درء الفتنة إذا ذر قرنها واستيقظ شرها وتطاير شررها والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها" فإن طاقات النفس محدودة وقدراتها تحت مطارق وصروف الهوان قاصرة. يخشى حالئذ أن تلين أو تهون أو تتشتت فتعطي خصمها الدنية في ذاتها ويقينها.
إذ التلويح والتلميح والمساومة والرغبة والرهبة من أخطر الأساليب التي تمس أغوار النفس في ظروف القهر والبغي والطغيان.
وما لم يتدارك هؤلاء تحت العذاب والفتن وسوط الجلاد ومعاول الهدم تنوشهم من باطنهم وظاهرهم ومن فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فإنهم لا يلبثون إلا ريثما تضيق على أعناقهم قبضة الفتن فإذا هم ساقطون.
أن القتال حينئذ حبل إنقاذ ينقذ المحطومين ويمنع المتآمرين من التوسع والمزيد، ولا ملام في هذا فمن أشعل الفتنة صلي نارها: ومن سل سيف البغي صرع به.
إن القتال في الإسلام كما يكون لأهل العدوان والاضطهاد والفتن، يكون أيضا لمن يهددون الأمن ويقلقون السلم.
ويكون لمن يدسون الدسائس، ويزرعون الوقيعة، ويبثون الخدع، وينشرون الأراجيف، وينفثون السموم، ويروجون لأساليب الهدم والدمار من المذبذبين. وذوي الضمائر الفاسدة والذمم الخربة وأهل النكت والخيانة.
ومن لديهم الاستعداد إلى الانسلاخ من كل مبدأ والتلون بكل لون، وتغيير جلودهم حسب الملابسات والظروف.
هؤلاء يجب أن يردعوا ويؤدبوا ويوقفوا عند حدودهم. سيما إذا ثبت بالاختبار أنه لا علاج لهم إلا هذا. كالعضو الفاسد لا علاج له إلا يتيره إن الإسلام دين الغوث والنجدة والشهامة ورعاية الحقوق وتعهد الذمم وتوطيد العلائق وتوثيق الصلات بين أهل الإيمان ومشاركة بعضهم بعضا في السراء والضراء.
ففي قلب كل مؤمن زرع الإيمان مركز استشعار تسجل وبذبذباته ومؤشراته خواطر الحق، وحاجات أهله، وتهتز أجهزته ملبية على أوسع مدى، وأسرع وقت بالغوث والتعاون داعيتهم، مغطية بالنفس والنفيس عوزهم، داعمة موقفهم بشرط أن يكون ذلك في نطاق الدين وبشرط ألا تخفر ذمة، ولا ينكث عهد، ولا ينقص ميثاق.
وكما يتعاون الكفر ويتضافر أهله ويتناصر ذووه فيما بينهم على الولاء والنصرة ودعم موقفهم ماديا ومعنويا. فأولى بالمؤمنين أن يجتمعوا على الإيمان، وأن يتناصروا على الحق والخير والعدل والإنصاف.
القتال في الإسلام: إذن قتال في سبيل الله دفاعا عن الدين والدعوة والحق والمبدأ والأرض والعرض والنفس والمال والعدل والخير والشرف الكرامة.
وما كانت أسباب القتال في الإسلام راجعة يوما ما إلى عدوان منه أو بغي أو تسلط أو قسر أو إكراه.
وما كانت أيضا هجوما، ولا معاداة، ولا باطلا. وإنما كان الأمر معه على العكس فالمسلمون كانوا على مر العصور ضحايا القسر والتعذيب والطغيان والقهر لذا لجأوا لمحاربة القوة. لأنه لا تحارب القوة بالحجة. ولكن بمثلها فلا يفل الحديد إلا الحديد فكانت حروبه جميعا دفاعية أو مبادرة لاتقاء هجوم مبيت من طغاة متجبرين لا يألون جهدا في مباغتة الإسلام بالهجوم عليه، والإيقاع به وفض الناس عنه.
ومما هو معلوم: أن الصراع بين الأحياء من طبيعة الحياة، وقد ثبت بالتجربة، أنه أمر لابد من وقوعه بين الناس، مهما ارتقت أفكارهم، أو تقدمت وتطورت معارفهم وحضارتهم.
والدليل الواضح على ذلك: ما يقع بين الأمم من الحروب العالمية، وهذا التسابق المحموم في أسلحة الفتك والدمار والخراب، رغم ما توصلوا إليه من العلم والحضارة المادية، والتقدم([21]).
فالحرب لا يمكن أن تزول من الدنيا، أو تخف حدتها، أو تحصر ويلاتها، ذلك أنها بكل ما فيها من مرارة وآلام، وبكل ما تنطوي عليه من قسوة، وبطش، وإخلال بالأمن والسلام، سر من أسرار الحياة، وجوهر من جواهرها..
لأن الحياة هي الحركة، والحركة هي التي تحول المادة وتغيرها، بما تحدثه من احتكاك وصدام، وصراع مستمر..
إن كل ما في الكون، من عناصر مركبة، أو بسيطة في كفاح مستمر، بين أجزائه المختلفة.. فالماء، والهواء، والحرارة، وبقية العناصر، كلها في حرب دائمة.. ومن هذه الحرب تنشأ جميع الظواهر الطبيعية والجغرافية، التي تؤلف مسرح الحياة.
فالرياح، والعواصف، والسحب، والبروق، والرعود، والصواعق، والسيول، والأمطار، والزلازل، والبراكين.. هي مظهر هذا القتال، فما من ذرة من ذرات الكون إلا ويجري فيها هذا الصراع.
وحسبك: أن تنظر إلى قطرة من الماء من خلال مجهر، أو ترى قطرة من الدم لترى فيها جيوشا جرارة، في كر، وفر، وإقبال، وإدبار، يلتهم بعضها البعض الآخر، بعد أن يصرعه.
فإذا شئت أن ترى ذلك مكبرا بالعين المجردة، فما عليك إلا أن تلقي بنظرة على الغابة، حيث تغص بالحيوانات الكاسرة، والطيور الجارحة، التي لا تنفك في حرب متواصلة، لا تفتر لحظة، أو تهدأ، ابتداء من الدودة الصغيرة، إلى الفيل الضخم..
ولو نظرت إلى قاع المحيط، لوجدت مثل ذلك جيوشا لا يدركها الحصر، تتباغى وتتقاتل، وتتصارع، حول الحياة والموت([22]).
وما كان الإنسان ليشذ عن هذه القاعدة، وهو أرقى صور الحياة وأملها، غير أن العقل والأديان، قد نظمت قواه، وحدت من غرائزه، التي تدفعه للقتال، دائما وأبدا..
لكنها لم تقض على هذه الغريزة.. وإلا لقضت على الحياة في أساسها، فبقيت غريزة القتال كامنة في النفوس، لا تلبث أن تحتدم، متى وجدت دواعيها، وتهيأت أسبابها.. وما أكثر الأسباب والدوافع، التي تفضي إلى المنافسة بين أبناء البشر([23]).
والإنسان حين يفقد سلامه النفسي في داخله، يفقد سلامه الاجتماعي والعالمي في خارجه، ويعدم الراحة، والهدوء، والانضباط، ويتلفت عن يمين وشمال، فلا يرى إلا جيوش الأهواء والنزوات، وفيالق الأثرة.
والمطامع تدق طبولها، معلنة، على قراره الذاتي، وسلامه النفسي، حربا ضروسا، لا تلبث إلا ريثما يضيق بها ميدان وجدانه، مجال مشاعره، لتمتد ألسنتها، حامية الوطيس، مشتعلة الأوار، خارج هذا النطاق، لتأتي على الأخضر واليابس، من علائق الأفراد والجماعات، والأمم، ومقدراتها، وممتلكاتها، ومناطق نفوذها،وما سطرته يراع الإنسانية من معالم الحضارة، ومشاهد التقدم، ووسائل المدنية، التي ترمي إلى ترقية الحياة، وتهذيبها..
والويل كل الويل، يوم يذر قرن الفتنة، وتشرئب الأهواء النافرة، والنزعات الشاردة، والمطامع الفاغرة، معلنة إصرارها على طمس الحق وأهله. لهذا كان حرص الإسلام البالغ، على أن يتصف أهل الإيمان بالقوة.
وعلى أن يكونوا دائما على استعداد، لمواجهة أهل الباطل، مهما تكن التضحيات في النفس، والأهل والمال.. والتحفظ الوحيد الذي وضعه الإسلام على قوة المسلمين، هو أن تكون قوتهم في خدمة العدل والسلام، وأن تنأى عن البغي والعدوان.
قال تعالى: (وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) [سورة الحج: 40].
ذكر القرطبي في تفسيره: أنه لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء المؤمنين من قتال الأعداء، لاستولى أهل الشرك، وعطلوا ما بنته أرباب الديانات، من مواضع العبادات، ولكنه دفع بأن أوجب القتال، ليتفرغ أهل الدين للعبادة.. فالجهاد أمر متقدم في الأمم، وبه صلحت الشرائع، واجتمعت المتعبدات([24]).
حقا: إن الإسلام حين يضطر إلى القتال، فإنما يمارس أشرف أنواع القتال وأنبله، ذلكم الذي لم ولن تعرف الدنيا له عدلا، ولا نظيرا، من قريب أو بعيد، من حيث أسبابه، وأهدافه، وغاياته، وملابساته، وظروفه..
إن أسباب القتال جميعا تلتقي عند درء العدوان، ورد الهجوم، واسترداد الحق السليب، والكرامة المهيضة، والأمل الشريد، واقتلاع جذور الظلم، وكسر حدته، وانحسار موجته..
ولولا أن يغري الله به المؤمنين، لاعتلت المفاهيم، واختلت الموازين، واضطرب أمر الحياة، ولخلا وجهها من الحق وجنده([25]).
وتلتقي أيضا بواعث القتال عند درء الفتنة، إذا ذر قرنها،واستيقظ شرها، وتطاير شررها، فإن طاقات النفس محدودة، وقدراتها تحت مطارق الفتن، وصروف الهوان قاصرة، يخشى حالئذ أن تلين، أو تهون، أو تتشتت، فتعطي خصمها الدنية في ذاتها، ويقينها.. إذ التلويح، والتلميح، والمساومة، والإلحاح، والرغبة، والرهبة..
ولذا لجأ المسلمون لمحاربة القوة بالقوة، لأنه لا تحارب القوة بالحجة، ولكن بمثلها، فلا يفل الحديد إلا الحديد، فكانت حروبه جميعا لاتقاء هجوم مبيت، من قبل طغاة متجبرين، لا يألون جهدا، في مباغتة الإسلام بالهجوم عليه، والإيقاع به، وفض الناس عنه.
إذن حتمية المواجهة تستدعي من المسلمين - أمة، أو مجموعة من المجتمعات - ضرورة التهيؤ، والاستعداد، وليس شرطا أن ينتظر المسلمون، حتى يروا أمارات السوء، والشر والعدوان، من عدو معروف لهم، فيبدأون في أخذ وسائل الدفاع.
إنما عليهم أن يدركوا طبيعة الحياة في هذه الزاوية الهامة، التي تحكم بوجود الصراع، تجربة، وتاريخا، واقعا، بين الناس، فيبذلون قصارى جهدهم، في إعداد القوة، حتى ولو لم يكن أمامهم عدو معروف، ومعلوم لهم.
وإلى هذا المعنى يوجه القرآن الكريم المؤمنين، فيقول تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ) [سورة الأنفال: 60].
فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاستعداد للحرب التي لابد منها لدفع العدوان وحفظ الأنفس، والحق، والفضيلة.. ويكون ذلك بأمرين:
الأمر الأول: إعداد المستطاع من القوة، ويختلف هذا باختلاف الزمان، والمكان، والواجب على المسلمين في هذا العصر، صنع المدافع والطائرات والدبابات وإنشاء السفن الحربية، والغواصات، ونحو ذلك، كما يجب عليهم تعلم الفنون والصناعات، التي يتوقف عليها صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب.
وقد استعمل الصحابة المنجنيق مع رسول الله صلي الله عليه وعلي آله وسلم في غزوة "خيبر" وغيرها. روى مسلم عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم ، وقد تلا هذه الآية([26]).
يقول: "ألا إن القوة الرمي" قالها ثلاثا. وذلك أن رمي العدو على بعد، بما يقتله، أسلم من مصاولته على القرب بسيف أو رمح أو حربة، أو نحو ذلك.
وهذا يشمل السهم وقذيفة المنجنيق والطيارة والمدفع والبندقية ونحوها.. فاللفظ يشملها وإن لم تكن معروفة في عصره صلي الله عليه وعلي آله وسلم([27]).
والأمر الثاني: مرابطة الفرسان في ثغور البلاد وحدودها.. إذ هي مداخل الأعداء ومواضع مهاجمتهم للبلاد.. والحكمة في هذا، أن للأمة الإسلامية جند دائم، مستعد للدفاع عنها، إذا فاجأها العدو على غرة.. (تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ) أي أعدوا لهم المستطاع من القوة الحربية، ومن الفرسان المرابطة، لترهبوا أعداء الله الكافرين به..
والخلاصة: إن تكثير آلات الجهاد، وأدواته، كما يرهب الأعداء الذين نعلم أنهم أعداء، يرهب كذلك الأعداء، الذي لا نعلم أنهم أعداء.
"وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم".. فالاستعداد للحرب يرهبهم جميعا، ويمنعهم من الإقدام على القتال.. وهذا ما يسمى في العصر الحديث، "السلام المسلح"([28]).
والآية الكريمة التي أمرت بإعداد القوة فيها كلمة "ترهبون" وقد جاءت بصيغة الفعل المضارع. تشير إلى الغرض من إعداد القوة، وهو إلقاء الرهبة في قلوب أعداء الله، وأعداء المسلمين المعلومين منه والمجهولين..
وكم للمسلمين والإسلام من أعداء، لو يفقه المسلمون.
والآية الكريمة "وأعدوا" على اختصارها جمعت أنواع الإعداد للجيوش التي تتلاءم مع كل عصر وزمن، كالإعداد المادي، والإداري، والفني، والمالي، والتخطيط، والدراسة الموضوعية لمقتضيات الأحوال..
ولقد فرض الإسلام على الأمة الإسلامية الإعداد بكل ما تشمله كلمة "إعداد" من معنى، وأن تبذل الأمة فيه أقصى الجهود الصادقة، ولم تغفل الآية الإعداد وقت السلم، ووقت القتال، حتى تكون الجيوش الإسلامية أشد فعالية، وأكثر قدرة قتالية.
والقتال في الإسلام مجرد من كل غاية أرضية، ومن دافع شخصي، ليتمحض خالصا لله لتحقيق كلمة الله، وإقامة العدل، ابتغاء رضوان الله([29]).
قال تعالى: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) [سورة آل عمران : 142].
والإسلام في هذه الآية الكريمة، يربط هذه الغاية المرجوة - دخول الجنة - بالسلوك العملي في الحياة الدنيوية، بحيث تصبح المقياس والميزان، الذي يدل على صحة الارتباط بالدين نفسه.. قال تعالى: (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [سورة التوبة : 14-16].
فكلمة "بأيديكم" في الآية تنفي تماما معاني التواكل، والإهمال، والكسل، وتؤكد حظ الجهد البشري في المواجهة لأهل الظلم والباطل. كما تفيد المسلمين، أنه لا أمل لهم إلا في أنفسهم..
وكلمة "أم حسبتم أن تتركوا" في الآية، فيها الدلالة الواضحة على أنه لا يجوز أن يتصور أهل الإيمان قيام الحياة ونظامها، على الخلو من معاناة الجهاد، والصبر، والبذل، والتضحية، وإن أي تصور يجنح إلى تجربة الحياة من غير هذه الخصائص، وهم باطل، لابد من محاربته، حتى يكون المؤمن مستعدا استعدادا واقعيا، يتمشى مع طبيعة الحياة([30]).
والأمة الإسلامية في أشد الحاجة إلى استيقاظ كل الخلايا فيها، واحتشاد كل القوى، وتوفر كل استعداد، وتجميع كل الطاقات، كي يتم النمو، ويكتمل البناء.
لأن تحركات الأعداء لا تتوقف، وتكالب الأعداء، يزداد شراسة وسعارا، ولا جرم، فإن الحق الأعزل ضائع([31]).
ولما كانت ظاهرة الصراع تتعلق باستمرار ذاتها، كان للاستعداد لها، والاعتراف بها، المكان المقدم في الإسلام.
ولذلك جاءت مقاييس التفاضل بين الأعمال، لتضع الجهاد في قلب المؤمن ونفسه، في المكان المتفوق على غيره من سائر الأعمال.
قال تعالى: (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيماً) [سورة النساء: 95-96].
والحق أن الذي يستعد استعدادا صادقا للبذل والتضحية والجهاد، تسهل عليه سائر العبادات..
لذلك فإن المؤمن في عملية الجهاد أو الاستعداد لها، يتجرد عن كل شئ، لله سبحانه وتعالى، وكأنه عقد مع الله صفقة أعطى فيها، وبها، لله كل شئ، ليفوز بجنة عرضها السموات والأرض.
قال تعالى: (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [سورة التوبة : 111].
وقال تعالى: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) [سورة آل عمران: 169] .
وهذا يعني أن أسلوب الجهاد ضرورة للحياة الكريمة، وأي تقصير في التهيؤ والاستعداد له، يعرض صاحبه لنقصان في الإيمان، وفساد في العقيدة، فعن أبي هريرة يروى أن رسول الله صلوات الله عليه قال: "من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه "بالغزو"، مات على شعبة من النفاق"([32]).
وقد روى الطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب"([33]).
والخلاصة: التي نفهمها من المنهاج القرآني والنبوي، أخذا من الآيات والأحاديث، التي جاءت في ميدان الجهاد، والقتال.. أن واجب الأمة الإسلامية أن تهيئ نفسها بصفة دائمة ومستمرة إلى ضرورة الاستعداد.
حيث إن هذا الاستعداد والإعداد، جزء من العقيدة، وركن من العبادة، وقد ربط الله بتحقيقه سعادة المسلمين في الدنيا، ونجاتهم في الآخرة، وإن الأمة الإسلامية تملك من الطاقات البشرية، والعقول المفكرة، والإمكانيات المادية، والمواقع والعزة والقوة والمقاومة، من أسمى القيم التي أرشد إليها الإسلام.. وجاءت دعوة الإسلام هذه من أجل الإنسان، ليحتفظ ببشريته حريته وكرامته وطمأنينته..
وكلما كان الإنسان مهذبا: كان مقدرا الروح الإنسانية، والإنسان المهذب لا ينزل بإنسانيته إلى الهون، ولا يقبل أبدا أن يتمرغ في الوحل. بل يسعى في استمرار إلى وضع إنسانيته في الوضع اللائق..
قال تعالى: (وَللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ) [سورة المنافقون : 8].
فالعزة صفة ذاتية لله جل شأنه، وخلق للرسول عليه الصلاة والسلام، وتخلق يجب أن يتخلق به المؤمنون. والرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن الكريم.
ولذا كان من خلقه القناعة التي هي مصدر غنى النفس وعزتها، أما المؤمنون فيقول العلماء، قد طلب إليهم - بعد ما استقر رأيهم، وأحرزوا النصر على عدوهم بفتح مكة، وبعد ما تلا ذلك من جمع شمل الأنصار والمهاجرين في وحدة واحدة وأصبحوا أمة متآخية - أن يمارسوا الجهاد الأكبر، وهو جهاد النفس.
وليس جهاد النفس إلا حملها على أن تتخلق بخلق القناعة لتصل إلى مستوى العزة والكرامة الإنسانية.
والعزة في الإسلام صورة عملية سلوكية تدفع إليها الإرادة القوية والعزم الصادق، والاستطاعة على التكييف. والعزة سعي لتحقيق المثل العليا في الحياة، ليكون للمسلمين تاريخ وحضارة وأمجاد.
وتاريخ المسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل، لم يقم ولن يقوم على تحقيق الشهوات والتواكل والاستجداء، ولكنه يتجسد بالبطولات والتضحيات والعلم والمعرفة، ومواكبة التقدم الحضاري.
ومن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره، يطلبها من عند الله وفي ظلال الإيمان بالله.
لأن الإيمان بالله ليس دعوة إلى الانعزال عن الحياة، وإنما حقيقة أساسية من حقائق الوجود، والإيمان في ذاته كفيل بتعديل القيم والموازين، وتعديل الحكم والتقدير، وتعديل النهج والسلوك وتعديل الوسائل والأسباب.
ويكفي أن تستقر العزة بمفهومها ومدلولها وفلسفتها في قلب الإنسان المؤمن لتقف به أمام الدنيا كلها بمن فيها وما فيها، عزيزا كريما ثابتا، غير هياب ولا وجل سواء وقع على الموت أم وقع الموت عليه.
والمعتز بالله لا يحني رأسه لمخلوق مهما كان، ولا لعاصفة طاغية. والمعتز بالله لا يقبل الإرتخاص، ولا يرضى بالابتذال. والعزة في الإسلام حقيقة تستقر في القلب وتملأ الإنسان المؤمن، قبل أن يكون لها مظهرا في دنيا الناس.
حقيقة تستقر في القلب، فيستعلي بها المسلم على كل أسباب الذلة والضعة والذوبان والانسلاخ.
حقيقة يستعلي بها المؤمن على نفسه الأمارة، ويستعلي بها على شهوات النفس، استعلاء على القيد والذل، واستعلاء على الخضوع الخانع.
ومن تحقق له هذا الاستعلاء، وارتشف من ينابيع الإسلام، وارتبط بالإسلام أخلاقا وسلوكا وفكرا ونظاما. فلن يملك أحد وسيلة لإذلال إرادته وإخضاع ذاته..
والعزة في الإسلام ليست كما يتوهم البعض: عنادا جامحا يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل، وليست طغيانا فاجرا وجعجعة وتشدقا وحذلقة، وليست اندفاعا يخضع لشهوة ويرتمي في تبعية، وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل، وليست فلسفة جاهلية وادعاء..
إذن وبكل تأكيد وبدون مجانبة للصواب، يمكن أن نقول إن: فلسفة العزة في الإسلام، خضوع لله وخشوع وخشية وتقوى ومراقبة وعمل.
ومن هذه المعاني وبها ولها ترتفع الجباء وتصمد النفوس، وبهذه المعاني سلطانهم، ولم يحدثنا التاريخ أن المسلمين يوم أن كانوا قوة، قبلوا أن يكونوا تابعين لأي قوة بشرية. والأمم كالأفراد، وما الأفراد إلا لبنات في بناء المجتمع الواسع.
والفرد في الإسلام جزء من المجتمع الإسلامي يكمله ويكتمل به، ويعطيه ويأخذ منه، ويحميه
ويحتمي به.
والأمة التي تفضل أو ترضى بالتواكل والاستجداء والكسل والتبعية، وتترك الاعتماد على النفس والجهاد في سبيل الله، أمة لا تستحق الحياة الحرة الكريمة، والحياة الحرة الكريمة لا تتأتى لأمة دون ثمن، والثمن هو التضحية.
ولا يتأتى لأمة أن تشق طريقها في الحياة، وأن تستعيد وجودها وكرامتها، وتعيد صنع حياتها، دون أن تحاول جاهدة أن تبني نفسها بناء يتفق مع الاعتداد بالذات.
وقد يكون من المسلمات البديهية: أن ضعف الأمة في جوهره وجذوره ليس ضعفا في قوة الدفاع أو في القوة العسكرية، وإنما يكمن في ذل النفوس وشعورها بالضعف.
وقد يكون من المسلمات البدهية أيضا: أن فقر الأمة في جوهره وجذوره ليس فقرا في السلاح والمعدات أو فقرا في المال والإمكانيات، وإنما يكمن في فقر النفوس وعجزها، وضعف الإرادة واضطرابها.
ولهذا جاء الإسلام بتعاليمه وآدابه وإرشاداته، داعيا المسلمين إلى التمسك بالعزة وبناتها: من الرفعة والتسامي والمنعة، وأبناء عمها: من الآباء والشمم والاستعلاء.
واستطاع الإسلام في قوة أن يغرس هذه المعاني في النفوس المؤمنة بالله المعتدة بعقيدتها.
وقد لاقى المؤمنون الأهوال والصعاب، وتجشموا المشاق والمخاطر. بصبر وعزم وحزم، وخاضوا غمار الحروب، واقتحموا ساحات القتال بإيمان وشجاعة واضعين في الاعتبار أن الجبن لا يطيل أجلا، والإقدام لا ينقص عمرا.
قال تعالى: (قُل لَّوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) [سورة آل عمران : 154].
وقال تعالى: (قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لاَّ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً) [سورة الأحزاب : 16].
وانطلاقا من هذه المفاهيم والقواعد، انطلق المسلمون في سبيل الله والعقيدة، انطلاقة أنقذت الإنسانية من وهدة الضياع والخسران، وأزالت الأصفاد والقيود التي كانت تقف حجر عثرة أمام تقدم الإنسانية واستتباب الإسلام.
وإن الحياة تتطلب من الأمة الإسلامية أن تطعم التاريخ خبر الشهادة والاستشهاد، وأن تغرس أقدامها في طريق السؤدد والمجد، وأن تربي الأجيال على الاعتزاز بالعقيدة وحب الخير والإصلاح والصلاح.
ولهذا كان لابد من اتجاه الأمة إلى تربية الأجيال، تربية إسلامية، تتولى المسئولية، والإدارة.
تربية تجعل الإنسان إيجابيا يعيش في حركة فكرية، ونفسية، وجسدية، بناءة، بعيدا عن السلوك التخريبي.. ورفض التحجر والجمود.. والإسلام لا يرضى بالسلوك الانسحابي الذي يتهرب من نشاطات الحياة، ويبتعد عن مواجهة الصعاب.
تربية تؤهل الإنسان للعطاء، وتنمي فيه القدرة على الإنتاج والإبداع، بما تفتح له من آفاق التفكير والممارسة.
تربية تعد الإنسان إعدادا ناضجا لممارسة الحياة بالطريقة التي يرسمها ويخطط أبعادها الإسلام، لأن الحياة في نظر الإسلام، عمل، وبناء، وعطاء، وتنافس في الخيرات.
تربية تجعل الشخصية الإسلامية شخصية متزنة، لا يطغى على موقفها الانفعال، ولا يسيطر عليها التفكير المادي، ولا الانحراف الفكري المتأتي من سيولة العقل وامتداد اللا معقول.
تربية تبني الإنسان على أساس وحدة، فكرية، وسلوكية، وعاطفية، متماسكة.. على أساس من التنسيق، والتوافق الفكري، والعاطفي، والسلوكي، الملتزم، الذي لا يعرف التناقض، ولا الشذوذ.
تربية تجعل الإنسان المسلم يشعر دوما أنه مسئول عن الإصلاح، وأنه يجب عليه أن ينهض بمسئوليته، ويقود نحو شاطئ العدل والسلام.
وإن أمتنا تتطلع إلى غد مشرق، والتطلع يحتاج إلى علم وعمل، وجهود بناءة تكون علامات مضيئة في الطريق.
وبناء على ذلك يمكن للأمة الإسلامية:
أولا: العمل على توحيد الصفوف. ويمكن ليمثاق الوحدة الذى وضعه المجمع العالمى للمذاهب فى طهران أن يكون رائد فى الموضوع.
ثانيا: العمل على نشر ثقافة الاعداد والاستعداد. ليكون ذلك حذوة اتقاد نحو مشروع نهضوى.
ثالثا: يتواكب الإعلام الإسلامى مع قضايا الأمة المصيرية.
رابعا: كشف وتعرية ألاعيب الدول الغربية الدامعة فى مجتمعات المسلمين.
الهوامش:
([1]). انظر الدكتور أحمد السايح: معارك حاسمة ص12-24 ط/دار اللواء بالرياض.
([2]). توماس الإكويني ولد سنة 1226م، وتوفي سنة 1274م ويعتبر من أعظم الفلاسفة واللاهوتيين في العصر المدرسي المسيحي، وفي 1323م منحته الكنيسة الكاثوليكية لقب القديس.
([3]). مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي، ص8، ط/ك دار بيورت 1969م.
([4]). انظر الدكتور مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص187-188، ط/بيروت.
([5]). انظر غوستاف لوبون: حضارة العرب، ص2، 4 ترجمة عادل زعيتر.
([6]). لوثورب ستودارد: حاضر العالم الإسلامي، ج1، ص60.
([7]). راجع نادية شرف العمري: أضواء على الثقافة الإسلامية، ص164.
([8]). إبراهيم النعمة: الإسلام أمام تحديات الغزو الفكري، ص12.
([9]). أنور الجندي: المد الإسلامي في القرن الخامس عشر الهجري، ص126.
([10]). الدكتور توفيق يوسف الواعي: الحضارة الإسلامية، ص704.
([11]). المصدر السابق.
([12]). نادية شريف العمري: أضواء على الثقافة الإسلامية، ص167.
([13]). عبد الرحمن الميداني: أجنحة المكر الثلاثة، ص13.
([14]). المصدر السابق.
([15]). المصدر السابق، وانظر عمر فروخ: التبشير والاستعمار، ص184.
([16]). الواقع أن اليهود لم يضطهدهم المسلمون، ولكنهم هم الذين اضطهدوا المسلمين وتآمروا عليهم.
([17]). انظر الدكتور توفيق الواعي: الحضارة الإسلامية، ص706.
([18]). انظر الدكتور توفيق الواعي: الحضارة الإسلامية، ص707.
([19]). المصدر السابق، ص707 وانظر أنور الجندي: المد الإسلامي في القرن الخامس عشر الهجري، ص286.
([20]). حديث صحيح رواه أحمد ومسلم والترمذي، الجمع الصغير، ج2، ص360.
([21]). الدكتور أحمد السايح: أضواء على الحضارة الإسلامية، ص179، ط/دار اللواء بالرياض 1401هـ.
([22]). الأستاذ أحمد حسين: الحرب على هدي الكتاب والسنة، ص11، ط/المجلس الأعلى بالقاهرة، 1974م.
([23]). المصدر السابق، ص11.
([24]). القرطبي: أحكام القرآن، ج12، ص70، ط/القاهرة.
([25]). نظام الحرب في الإسلام: الدين والحياة، وزارة الأوقاف، مكتبة الإمام، ج14، ص12، ط/الأوقاف المصرية 1973م.
([26]). آية سورة الأنفال "وأعدوا لهم ما استطعتم".
([27]). الدين والحياة، نظام الحرب في الإسلام، ص6، ط/وزارة الأوقاف.
([28]). الشيخ المراغي: تفسير القرآن الكريم، ج1، ص25، 26، ط/القاهرة.
([29]). د. أحمد السايح: أضواء على الحضارة الإسلامية، ص182، ط/دار اللواء، الرياض، المملكة السعودية.
([30]). وزارة الأوقاف، نشرة رقم 88 من سلسلة الدين والحياة، ص8، ط/وزارة الأوقاف.
([31]). د. أحمد السايح: أضواء على الحضارة الإسلامية، ص185.
([32]). المنذري: الترغيب والترهيب، ج2، ص253، والحديث رواه مسلم وغيره.
([33]). المصدر السابق.

