العالمية والخاتمية والخلود في الفكر الإسلامي
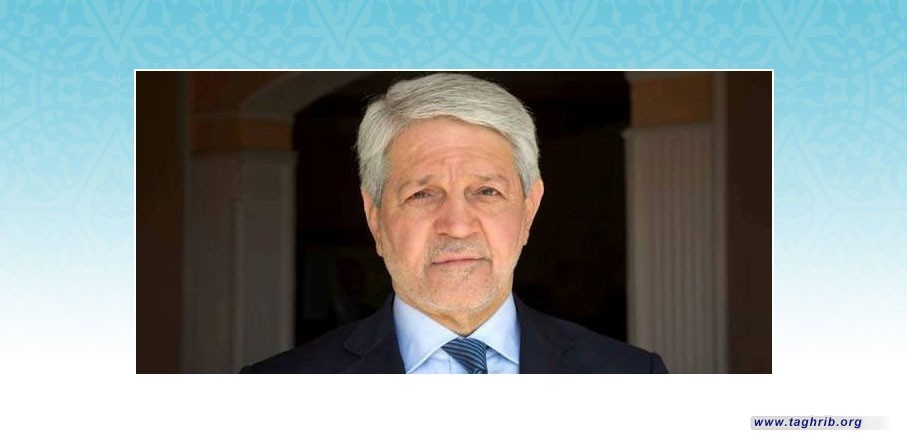
العالمية والخاتمية والخلود في الفكر الإسلامي
المهندس بيان جبر
العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
حين يكون الحديث عن (الخصائص) فأن العالمية والخاتمية والخلود تصبح من أولويات المنهج الفلسفي الذي يرتكز عليه التصور الإسلامي في علاقته بالحياة والقانون والمدنية والدولة وحركة التاريخ وأنماط التنمية والمعارضة والسياسة.
لكن... ما الجدل الداخلي الذي يدور بين معادلة هذا الثنائي الصارم المنهج الخصائص، حيث يتعلق الأمر بماهية تشريع الوحدات الأساسية في مشروع الإسلام أو وحدة العبادات وما الذي يثيره الإسلام حيث يتحدث عن المشروعات والتيارات الفكرية الموازية أي التي تطرح نفسها أما رديفا لتشريعه في الحاكمية أو تلك التي تقف ضده في تهذيب المجتمع البشري كبديل عقيدي وأخلاقي لحركة عقيدته وأخلاقه في الحياة ؟..
الإسلام قائم على مبدأ التنوع وإلا لما تميزت تشريعاته (بالمرونة) و (الواقعية) في تعاملها مع المسائل المعقدة والقضايا التاريخية الشائكة ولو لا
ـ(220)ـ
مرونته وواقعيته في الصدق مع النفس ومحيطها والعالم وبيئاته الفكرية والقومية والاثنية والعرقية لما تسنى لشريعته ان تطرح نفسها بوصفها الشاهد على عالميته.
عبر التنوع اخذ التشريع المقدس بضرورة تحديد الصياغات النهائية لوحداته على اختلافها واختلاف بيئاتها وشكل على الأساس ذاته صيرورته في التكوين الذاتي للمجتمعات والأفكار بحيث لا يمكن الفصل على ضوء مبدأ التنوع هذا بين وحدة القانون ووحدة الدولة وحدة السياسة وحدة الفقه وحدة التنمية، وحدة القضاء والعلاقات الاقتصادية والأخلاقية والتربوية على ان ذلك تم وفق جدل بين أصل تشريع (الوحدة) وإمكان تثويرها في الواقع الإنساني وتوظيف استعدادها الداخلي في الارتفاع (بمدنية) المشروع المراد الاشتغال عليه، من دون ان تطرأ على خط وحدة التشريع استثناءات الخروج على السياق.
التشريع وحدة فكرية متماسكة تحت أي ظرف ومتغير زماني لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها كما يقول الفلاسفة ـ وحدة يتماهى في داخلها المفعم بالحيوية والقوة نسق العلاقات البشرية في جدل لا يحسم الصراع لطرف دون آخر فلا التشريع يصرع البشريات كونه لم يأت إلا لحسم موضوعة القيمومة المهذبة بأخلاق العرش الإلهي المقدس عبر إمكانات البشر الإلهية ولا البشرية قادرة على التماهي مع مقاييس العدالة الاجتماعية والسياسية والاتساق مع تكون القيمومة بلغة العرش إلا بمنهج الشريعة.
لذا عبرت الشريعة عن أرقى حالات تجسيد القيمومة الإلهية على البشرية من خلالها ومن خلال فسحها لمجالات تثوير الطاقات والإمكانات العقلية خدمة لأغراض العمران البشري، الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي، المدني.
إذا اعتبرنا الشريعة الربانية هي الوحدة الفكرية الأولى التي بادرت لتوظيف
ـ(221)ـ
إمكانات العقل إزاء العمران فأن ماتلاها من وحدات فأن هذه الوحدات هي تعبير فلسفي صادق لمعنى الوحدة التشريعية الأولى، لذا عبرت وحدات الدولة والقانون مثلا عن سر الوحدة التشريعية وهكذا تندرج بقية العناوين في سياق فهم الشريعة وقدرتها في تمثيل الحياة.
ان الشريعة الإسلامية التي أخذت على عاتقها قيادة الحياة والأمة معا أدركت وفق لغة القرآن والسنة ومدرسة أهل البيت عليه السلام وتراث الفقه والمعرفة ان وحداتها لا يمكن ان تكمل الواحدة الأخرى إلا وفق نسق يتعايش بممكناته الفكرية والعلمائية بصورة تبدو فيها الدولة والقانون والقضاء والعمران والتعزيرات ذات طابع توحيدي صارم قادر على الحياة وفق أي ظرف ومتغير سياسي أو اجتماعي سواء داخل إقليم الدولة الإسلامية أو ما يطرح في البيئات المدنية خارج حدودها.
لنأخذ مثالا حيا على ذلك:
الدولة الإسلامية مشروع لأحياء الأرض بما يعني الأحياء في لغة الفلاسفة من أحياء الأرض كأرض عميقا في تثوير إمكانات العقل وقدرته على فعل الحضارة بكافة أشكالها وأنماطها الاجتماعية، الثقافية، السياسية، الاقتصادية، الأخلاقية، وهذه الدولة لا يمكن إقامة حدودها الاعبر إقامة وحداتها بالشكل الذي تقوم فيه كل وحدة تغذية الأخرى على نحو الأفئدة والتوظيف خدمة لهدف أعمار الأرض وأحيائها من هنا يبدو عسيرا إقامة وحدة للنظام الاجتماعي إذا لم يترافق معها وبشكل حيوي وحدة للنظام الاقتصادي، ذلك ان قيام (مجتمع) مدني لابد من وجود اقتصاد يكفل لهذه المدنية استمرارها وقدرتها على الحياة
ـ(222)ـ
وإلا فأن قيام (اجتماع) بشري ـ مدني في دولة تدعوا إلى الإسلام من دون مادة اقتصادية ترعى مدنيته وتطوره وتكفل محروميه من أصحاب الدخول المحدودة يستحيل على هذا المجتمع الاستمرار بمشروع الاحياء.
وإذا كان نظام الوحدة الاجتماعية لا يستقيم بناؤه إلا بكفالة وحدة للنظام الاقتصادي تعضده في حركته بأتجاه العمل النهضوي القادر على إسناد الدولة الإسلامية والدفاع عن ثغورها وتسنده في صيرورة جدله العقلي في المعرفة وبلورة مشروعه الخاص تعبيرا عن الفقر والطبقية والتخلف فأن القضاء كوحدة ثابتة من وحدات الفكر الإسلامي ودولته الإسلامية معني بالوحدتين الاقتصادية والاجتماعية وقد ذكر الشهيد الصدر في كتابه (اقتصادنا) ان الحاكم الشرعي (القيادة) لا يحق لـه مقاضاة السارق للوهلة الأولى قبل معرفة الدوافع الاقتصادية التي دفعته لارتكاب جريمة (السرقة) فربما قام بهذه الجريمة كونه (مضطر) بالشكل الذي لم يستطع فيه من كبح جماح نفسه وهنا على الحاكم الشرعي (القيادة) ان تصون المجتمع الإسلامي (اجتماعيا) و(اقتصاديا) من خلال برنامج اقتصادي لا يدع مجالا للسرقة ولذلك كان يندر وجود فقير في شوارع الدولة الإسلامية التي كان يقودها الإمام علي عليه السلام ولعل حادثة الرجل (الذمي) الذي كان يتسول في الشارع خير مثال يمكن اعتماده في تقييم تجربة دولة علي عليه السلام فحين وجد الإمام (الرجل الذمي) على هذه الحالة في الشارع أومأ إلى من كان معه قائلا: ما هذا و (ما هذا) دلالة للظاهرة أي ان الإمام كان يؤشر على ظاهرة اجتماعية اقتصادية جديدة في سياق التجربة السياسية التي كان يقودها واستغرابه من وجود رجل فقير في دولته مما يشير إلى ان تجربة الإمام علي عليه السلام كانت أخذت بالاعتبار فهم وحدات الشريعة الإسلامية وعدم انفلات وحدة من هذه
ـ(223)ـ
الوحدات عن مدار الوحدة الكلية.
وإذا كانت وحدات القضاء والاقتصاد حالات تؤمن بيئة تكاملية وأخلاقية تمنع من تزايد ظواهر الشح الاجتماعي والطبقية والعدوان والإرهاب الداخلي وتعزز الرصيد الداخلي في علاقة الأمة بقيادتها التي تستمد (شرعيتها) من استقامتها في طريق خدمة إطار الدولة والأمة معا فأن الوحدة السياسية كما اعتقد من بين أهم الوحدات المركزية التي تحظى بأهمية بالغة في مشروع الدولة الإسلامية وفي سيقا تطورها وصيانة حدودها وحماية إنجازها الإلهي وبقائها ممثلة للعدالة الربانية في سياق الحياة الإنسانية ـ فالوحدة السياسية تعنى بقضايا الثغور والاقليات الدينية والقومية وحق الأحزاب السياسية وأعداد القوة العسكرية، وصيانة التحالف الاقتصادية والسياسية مع الدول والمنظومات الدولية وحرية المعارضة المدنية وإطلاق حركة الثقافة والرأي الآخر وما يتعلق بالحريات الأساسية التي كفلها الإسلام وبناء المؤسسات وضخ مفاهيم الثورة والنهضة من اجل إبلاغ رسالة الله في الكون كله.
الإمام علي عليه السلام يرسم شواخص لهذا الوحدة من خلال تأكيده على جملة من المعالم الإلهية في فهم (سياسة البلاد) عبر رسالة (العهد) لمالك الاشتر يقول الإمام عليه السلام:
فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فأملك هواك، وشح بنفسك عما لا يحل لك، فأن الشح بالنفس الأنصاف منها فيما أحبت أو كرهت وأشعر قلبك بالرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فأنهم صنفان أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق.
ما يمكن الإفادة من شذرات هذا العهد فيما يتعلق بالوحدة السياسية ما يلي:
ـ(224)ـ
1 ـ ان الحاكمية الإسلامية، هي حاكمية الله سبحانه وتعالى في الحياة الإنسانية والشريعة إنّما جاءت لكي تنظف المجال الإنساني من عبادة الأوثان والقفز عليها بالنظرية التوحيدية للوصول إلى الهدف النهائي وهو تشكيل مجتمع إسلامي قادر على العبادة الواعية.
2 ـ ان القيادة الإسلامية وهي تقود إقليم الدولة الإسلامية لا تقوم بمبدأ القيادة إلا تأدية لوظيفة شرعية إلهية مؤادها خدمة الرعية (المجتمع) وإحلال النظام الإسلامي في إطار العمل الصالح، أي العمل الذي يؤدي وظيفة القيادة والنهوض ببرنامج التنمية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعبادية وتأدية ذلك كله في نطاق القيام بوظيفة التشريع.
3 ـ إقامة العدالة الاجتماعية الربانية بأبهى نماذجها وصورها عبر نفي الطبقية وفتح منافذ الاقتصاد وتنظيم العلاقات الاجتماعية بالشكل الذي ينفي الظلم والتعسف.
4 ـ الإسلام القائد ينفي الظلم بجميع مظاهره وظواهره ويستجيب لكافة التنوعات البشرية حتى وان اختلفت توجهاتهم الأيديولوجية النقيضة مع طروحات الإسلام وفهمه للحياة فالإنسان في قيم الفكر الإسلامي والدولة الإسلامية أما أخ مؤمن بالطرح والقيم الإسلامية ويستجيب لفهم الإسلام أو نظير في الخلق وإذا كان كذلك فأنه يعيش بأمان وسلام واستقرار في إطار الإسلام.
5 ـ النهي الشرعي الجازم عن كافة أشكال استغلال الرعية (المجتمع) عبر (الاستأساد) عليهم والبحث عن كل الأساليب والسبل لتطويعهم وإرغامهم على قبول ما لا ينسجم وتعاليم الإسلام.
6 ـ من أرقى التعاليم التي خص بها الإمام علي عليه السلام واليه مالك الاشتر قولـه:
ـ(225)ـ
(واعلم يا مالك اني وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور وان الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك) وفي هذا دلالة كبيرة على عدة مجالات منها:
ـ ان مسؤولية إظهار نموذج العدل الإسلامي الحقيقي مسألة تبقى على الدوام هم القيادة التي تبحث عن المعنى للعدل الاجتماعي لا الضرورة الظاهرية لـه في أوساط الناس.
من هنا يوصي الإمام القائد واليه مالك بالعدل كأنقى نموذج يمكن ان يكرس فيه مالك صورة الدولة التي تقوم على العدل أليس بالعدل قامت السماوات والأرض.
ـ في دعوة الإمام للعدل أضاءت لجانب معرفي كان على الدائرة الإسلامية توسيع دائرته وكشف دلالاته بلحاظ، ان الإمام أكد لمالك ان مصر جرت عليها مشاريع دول امتازت بالجور تارة والعدل تارة أخرى، ولكي تكون مصر حالة عدل بالإسلام فأن الأمر يقتضي (حكما) من نوع مختلف، حكما يمتاز بالحزم أمام حالات النكوص والتهور والفوضى والعفو الاجتماعي لإضاءة المفهوم أكثر.
ـ الإمام علي عليه السلام لم يول مالك الأشتر على إقليم مصر إلا بعد شعوره ان مالك دائم الاشتغال بأمور الولاة الذين كانوا يعملون في إطار الدولة الإسلامية، أولئك الذين من حيث يشعرون أو لا يشعرون يسيئون لحاكمية الإسلام من هنا كان الإمام يحذر الاشتر من الوقوع بنفس الملاحظات التي كان يعاني منها الولاة السابقون ولهذا إشارة من ان الإمام القائد كان يركز على ماهية الوحدة السياسية وانزلاقات الخروج منها.
ـ(226)ـ
المعارضة والوحدة السياسية:
يقول المرجع المفكر الشهيد الصدر: الأمة هي صاحبة الحق في الرعاية وحمل الأمانة، وأفرادها جميعا متساوون في هذا لاحق أمام القانون ولكل منهم التعبير من خلال ممارسة هذا الحق عن آرائه وأفكاره وممارسة العمل السياسي بمختلف أشكاله كما ان لهم جميعا حق ممارسة شعائرهم الدينية والمذهبية فمبقدار ما يتقرب الحاكم من فهم هذا الحق للأمة ويروضها، أي يدربها على الرقابة والجرأة ـ جرأة النقد ـ يمكن تحديد شرعيته القانونية من عدمها وبمقدار ما يوظف النص لاحتكار السلطة واحتكار القرار السياسي بعيدا عن رقابة الأمة، ومشورة رجالها وأهل الحل والعقد منها يمكن تحديد هويته الاستبدادية والسلطوية.
ويؤكد الشهيد المطهري (بما ان ثورتنا تطالب في حقيقتها بالعدالة فعلينا جميعا ان نحترم الحريات بكل معنى اللكمة، لأنه لو أرادت حكومة الجمهورية الإسلامية ان تخلق جو الكبت والضغط فأنها تتحطم لا محالة، الإسلام دين الحرية، ودين يريد الحرية لجميع أبناء المجتمع ولاشك ان الحرية تختلف عن الفوضى وان غرضنا من الحرية هي الحرية بمعناها المعقول).
لا أحد يشك بأن يستحيل حصول إجماع كامل داخل أي مجتمع من المجتمعات وفي ظل جميع الأنظمة السياسية حيال قضية أو فكرة ما في جميع مجالات الحياة فتعددية المواقف والآراء، وتنوع المشارب والأهواء، حالة طبيعية تنعكس على شكل تعددية فكرية وسياسية وثقافية ومن طبيعة هذه التعددية انها تقود إلى تمايز المجتمع السياسي إلى تيارات وأحزاب ولا يمكن والحال هذه توقع سيادة نظرة اجتماعية اجماعية إلى جميع السياسات والبرامج في مجتمع
ـ(227)ـ
الدولة الإسلامية بل قد يصل الاختلاف في الرأي في السياستين الداخلية والخارجية إلى مستوى التقاطع والتضارب، فريق يرى صحة مواقف النظام السياسية، وفريق يرفضها وثالث يقف موقف الوسط، وهكذا وفيما سبق تاريخيا لم يكن هناك خلاف على هوية النظام السياسي الإسلامي وقاعدته الفكرية الإسلامية فليس هناك من كان يدعوا إلى علمنة الدولة والمجتمع كما يحصل هذه الأيام، صحيح ان أكثر السياسات والممارسات كان فيها تجاوز الشرع ومبادئ وقيم الإسلام وهي في مضمونها علمانية صريحة إلا ان الدعوة الصريحة أي فصل الإسلام عن النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي لم تكن موجودة بل حتى في أشد حالات الانحراف، كانت الشرعية الإسلامية والاصطباغ بصبغة الإسلام هي المعيار.
إلا انه في عصر الهيمنة القيمية الغربية، صار قطاع من الأمة يدعوا إلى العلمنة الشاملة والجزئية، ومعنى ذلك ان النظام الذي يستند في سياسته وفكره وأحكامه وعلاقته الدولية إلى القاعدة الإسلامية يواجه معارضة ترفض القاعدة الفكرية للدولة، فإلى القاعدة الإسلامية يواجه معارضة ترفض القاعدة الفكرية للدولة، فإلى أي مدى يسمح على مستوى الجهات السياسية لهذه المعارضة في ممارسة النشاط العام ؟ ومتى تكون مشروعة أم لا ؟ وهناك المعارضة التي لا تختلف مع القاعدة الفكرية العامة للدولة ولنظامها السياسي ولا من توجهاتها ومبادئها ولكنها قد تختلف في تفاصيل السياسات العامة على الصعيد الخارجي أو المحلي، وفي أساليب التعبئة العامة والإدارة وطريقة التغيير الاجتماعي والتنمية، وفي هذه الأطر قد يعارض زعيم سياسي وتكتل اجتماعي، وتيار طبقي وجماعات الأصناف.
فهل ان وضع هذه القوى يعني بالضرورة خضوعها لرأي التيار الغالب في
ـ(228)ـ
المجتمع وهل يمكن لجمها عند التعبير عن آرائها والدعوة إليها واستخدام أساليب متعددة وحديثة في استقطاب الرأي العام ثم هل يجوز إسكات هذه القوة بالضرورات الأمنية والسياسية وحدها وفي مدى زمني عام غير محدد أم أن حقها في الاعتراض والتجمع والنقد وإبداء الرأي يبقى حاكما وأصيلا على أدلة المنع المنطلقة من حالات الضرورة؟
ان حق الاعتراض يرتبط بمبحث الحرية والحقوق السياسية والاجتماعية وهو نابع من حق العضوية والمواطنية في المجتمع وأصالة حق المشاركة في السلطة وممارستها فعليا وحق التنظيم والمشاركة في التجمعات (الأحزاب).
ان أهمية النظر في هذه القضايا تستدعي درجة من الفقاهة والاستيعاب للموروث الفقهي وللتجربة التاريخية ولهذا لا يمكن القطع والتثبت في الرأي دون التوفر على الملاكات الآنفة لكن دورنا سيكون الاستعانة بآراء الفقهاء وإثارة الأسئلة وهي مهمة جدا في هذا المجال كما ينبغي إثارة المبادئ التالية:
1 ـ مبدأ عدم بطلان حق المسلم.
ففي خبر أبي عبيدة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام (لا يبطل حق امرء مسلم) وفي خير الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام (لا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم).
2 ـ تساوي الأفراد دون تمييز في الحقوق والواجبات.
3 ـ مبدأ حفظ النظام العام.
4 ـ مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لأئمة المسلمين.
5 ـ مبدأ حق الإنسان في ممارسة الحرية السياسية والفكرية ضمن حدود القاعدة الفكرية للمجتمع والدولة.
ـ(229)ـ
هنا تثار الإشكالية التالية:
هل تصل حدود الحريات السياسية إلى مستوى الدعوة إلى تداول السلطة في دولة إسلامية ليتمكن حزب علماني مثلا من ان يستفد من الحرية ليوجه ضربة إلى القاعدة الفكرية للدولة لأنه يريد الانسجام مع وضع دولي ضاغط وأيديولوجية الحضارة الغربية يقول الشيخ شمس الدين (لا يعقل ان تشرع عقيدة إلغاء نفسها لأنها لمجرد ذلك تكون قد عبرت عن عدم صدقيتها وعدم حقانيتها، حتى لو أخذنا مثلا المجتمعات الديمقراطية الغربية هل تسمح فلسفتها التي تصدر عن الليبرالية والمذهب الرأسمالي في الاقتصاد بقوى واتجاهات من شأنها ان تغير جوهر هذه الفلسفة ؟ ان السماح بوجود أحزاب شيوعية مثلا في بلدان رأسمالية لا يعدو شكلا من أشكال ألوان الديمقراطية وهو وجود شكلي يأسس حرية مضبوطة النتائج ولا تهدد أسس النظام وفلسفته).
يبقى ان نشير هنا ان (الوحدة السياسية) في النظام الإسلامي وفي الوقت الذي تجد فيه من حقها الدفاع عن قاعدتها الفكرية ووحدة الأمة ومسيرتها باتجاه التشريع وصون منعتها تعني إتاحة الفرصة أمام الاتجاهات الفكرية والسياسية في إطار الدولة كي تكون هذه الاتجاهات العين الساهرة التي ترعى مصالح الدولة العليا من دون فرض وصاية عليها أو حذفها.
الديمقراطية ـ العالمية ـ التعارض والاتفاق:
الإشكالية هنا هي ان بعض الإسلاميين يسعون لتوظيف الديمقراطية كأداة للوصول إلى السلطة فإذا وصلوا إليها تخلوا عن الديمقراطية بذريعة ان تطبيق الإسلام لا يتحمل ذلك إلا يعني هذا استحالة الديمقراطية إلى قناع للاستبداد ؟
ـ(230)ـ
للإجابة نقول: المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية تعاني من نظم الاستبداد سواء في المرحلة التي سبقت الأنظمة العلمانية التي تحكم مجمل البلاد العربية والإسلامية أو في ظل الأنظمة العلمانية التي تحكم البلاد الإسلامية اليوم ما عدا إيران ـ ثمة تشابه وتماثل بين النظام الإسلامي الاستبدادي من حيث الاستبداد الذي ميز مرحلة الحاكم العثماني وبين الأنظمة العلمانية الآن التي تعتمد النظم الاستبدادية.
الإسلام ان لم يكن وعد بتحرير الإنسان المسلم والعربي من النظم الاستبدادية، فيمكن القول انه لا حاجة للمسلمين والعرب به، وان حاجتنا إلى الإسلام لا حدود لها، ولكن من أهم أولويات هذه الحاجات حاجتنا إلى النظام الشوروي.
ان التيارات الإسلامية التي تعارض اليوم الأنظمة في الساحة يبج ان تركز على أمر أساسي في النظام الإسلامي وهو إمكانية تمثيل القطاعات الشعبية، لذلك فأن أي عملية تحول في عرنا الحاضر لتنقلنا من النظم التي جلبت لنا التخلف والهزائم يجب ان يكون في أساسها أن السلطة إنّما ينتجها الناس، أي يختارها الناس.
من هنا يمكن تلخيص رأينا بوحدة الدولة بما يلي:
1 ـ إنها ظاهرة قاعدتها الفكر الإسلامي وساحتها الأمة وهي وسيلة للوصول إلى الغاية الأساسية منها والتي تتعلق بتعبيد الناس إلى الله كما أكده الإمام الخميني رضي الله عنه في مرات عديدة.
2 ـ هي الساحة الفعلية الحقيقية التي يختبر الناس فيها مدى كفائة الأطروحة السياسية التي تعكس أمانيهم وطموحاتهم وأهدافهم في الحرية والتكافئ
ـ(231)ـ
والكرامة والتعايش الاجتماعي والسياسي مهما تعددت العناصر البشرية وتنوعت مشاربها القومية والأثنية والدينية.
3 ـ هي الحد الفاصل بين الهوية الذاتية المستقلة للإنسان المسلم من اللاهوية، فما بين ان تكون أو لا تكون وتنجز أهداف الأطروحة التي تنتمي لها، ينبغي التناهي بين فهم حدود الشخصية واستقلالها وفهم حدود الدولة كونها وحدة مستقلة تضفي على الشخصية أصالة الحرية وأصالة الانتماء للمشروع الاجتماعي السياسي الإسلامي.
4 ـ الإسلام يعبر عن شمولية أفكاره ونمط خطه في الحياة والمجتمع والتنمية والحرية وقيم الجهاد والتغيير والاستقلال والكرامة عبر حاضنة الدولة وإلا يبقى الإسلام وعناوين مشروعه في الحياة حلما جميلا يراود نفوس العاملين في سبيله.
5 ـ هي مقياس عدالة القيادة الشرعية في تعاطيها مع الأمة انطلاقا من أسس الإسلام وعدالته ونمط سلوكه العقائدي.
خلود الدولة ـ الأمة:
عندما جاء الإسلام بالأمة، لم يقرنها بحتمية نظامية معينة ومن هنا صارت (قيمة عليا) ثابتة لا تحبسها أطر جامدة بل هي القادرة على إيجاد الأشكال والصياغات النظمية التي تتلائم ومعطيات العصر وقد جاءت أحداث المنطقة الإسلامية في السنوات الأخيرة لفرض منطقها على الأوساط العلمية المتشككة في حيوية الأمة لتدفعها دفعا ان تعيد النظر في حساباتها وتجعل موضوع بحثها وجود هذا الجسد الحي المتماسك، الذي تكون أعضاءه من الشعوب الإسلامية
ـ(232)ـ
جمة والتي بدت وكأنها في عزلة وانفصال عن بعضها من خلال الحواجز الإقليمية والسياسية والمتباينة بل والمتناقضة والدولة ليست أمر مستحدثا وإنّما المستجد هو شكلها وليست القضية تنوع أنماطها في هذه الجماعة البشرية أو تلك.
ولأن قضية الدولة مرتبطة بتراث الأمة فأنه يتوجب قراءة معنى (خلودها) بتطور الشريعة والأنماط السلوكية والعقائدية التي كرستها عبر تطور الفكر السياسي الإسلامي وقدرته على بسط أنواع الدولة التي طرحها على الجماعة الإنسانية ـ الإسلامية والتفرد عن غيرها الذي لازمها في حركيتها وانفصالها مع هذه الجماعة.
ان الفارق بين الدولة في الإسلام وخلودها عن غيرها من الدول ومفهوماتها يمكن في تصورنا بالفارق العقائدي أي السقف الفكري والقاعدة الأيديولوجية والفلسفية التي تحتضنها وتوظف أشكالها وممارساتها في الحياة الاجتماعية في الإسلام ففي حين أحدثت التحولات الديمغرافية في الغرب خبرتها وبشريتها في الأنماط السياسية للدولة منذ عقد جان جاك روسوا الاجتماعي وتغيرت طبائعها وقوانينها ونظرتها للدستور والحريات وهي تحولات مرتبطة بتوق الخبرة البشرية في رؤية الدولة خالية من الوصايا الكنسية بقيت (الدولة) في المفهوم الإسلامي (خالدة9 لجوانب تتعلق بفلسفتها وماهية المعرفة التشريعية التي كانت على الدوام تعمق العلاقة بين معرفة التشريع والسلوك السياسي البشري الذي يلازمها، بين واقعية الفكر الإسلامي الذي يشيد دعائم السياسة وممارساته على أسس واقعية ومنطقية تدفع الإنسان إلى ريادة الممارسة إيمانا به في العقل التطبيقي وبين (بشرية) القيادة التي تلازم التشريع حسب ما يتطلبه موقف المصلحة من تطبيقه.
ـ(233)ـ
بمعنى آخر لم تحول (الدولة) في الإسلام وعبر صيرورات تطورها التاريخي منذ تجربة المدينة من ملكية إلى جمهورية كما حدث في أوروبا ولا من دستورية إلى مؤقته كما في بعض نماذج الشرق الأدنى بل بقي النموذج المدني دالا على ذاته كاشفا عن عمق ارتباطه الوثيق بتجربة التشريع ونموذجه الذي تأسس في القرن الهجري الأول.
هذا لا يعني ان ارتباط مفهوم الدولة بتجربة القرن الأول الهجري هو ارتباط ميكانيكي لصق بتلازم التجربة في جميع ممارساتها وأساليبها من دون أعمال ذهنية التطور على اجتهاداته ومقايسها في مجمل العقد المستعصية في الاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية والأخلاق والعلاقات الخارجية والعلاقة مع الآخر بل ظلت (الدولة) في الإسلام مفهوما تطبيقيا مشدودا بقوة إلى مجال التطور السريع في مجمل الأنماط الطارئة والمستحدثة في الحركة الإنسانية التاريخية وهذا سر خلودها، على ان (الدولة) في الإسلام يخلدها تطورها ويجعلها مندكة بشكل فاعل في (ميكانزم) المكان والزمان لاتبارحه إلا وهو اقدر على تشخيص مصلحته ومصلحة أجياله، والتجربة التاريخية الإسلامية تتحدث ان المجتمع الذي عاصر علي بن أبي طالب عليه السلام وسنوات قيادته كان يتوق إلى أيام علي عليه السلام حين غزتها تيارات الجاهلية الأموية التي استبدلت مفهوم الدولة في الإسلام إلى ملك قبلي جاهلي لركائز النظرية وأسسها.
على صعيد الأمة يطبق فقهاء العلوم السياسية على تفعليها لدور النظرية السياسية الحاكمة بـ (الاقتدار العالي المنبثق من الوجود السياسي لها) ولان الأمة آمنت بالإمامة مبدأ تطبيقيا لنظريتها السياسية الاجتماعية العقائدية فقد فعلت خلودها على مستوى الدولة عبر عدة مجالات شرعية، فالنظرية السياسية التي
ـ(234)ـ
صاغها النائيني تحت عنوان (المشروطة) تنبثق من الإمامة وهكذا تجلت (الدولة) في الراهن السياسي الفعلي عبر تراكم هائل من تجارب الاقتدار السياسي المنبثقة من مجالها العقائدي وتعتبر نظرية (ولاية الفقيه ) لدى الإمام الخميني رضي الله عنه من الإمامة، ومن النظريات التي كان لها الدور الأساس في إحقاق مطالب الشعب الإيراني وانتصار ثورته في قرن سياسي تراكمت فيه نظريات سياسية دولية وقفت وتقف باستمرار في وجه أي تحول سياسي إسلامي.
والإمام الخميني رضي الله عنه الذي قاتل منذ ما يقرب نصف قرن وأكثر من أجل تكريس حكومة الإسلام لم يتوصل لهذه النظرية السياسية التي أثبتت مصداقيتها في البقاء والاستمرار والتطور ومراكمة مفاهيم الدولة عبر شاخصها السياسي في إيران إلا حين أدرك ان النظرية تنسجم إلى حد كبير مع مبررات الثورة، واستعداد الأمة، وتوجها لمشهد الظهور النهائي للدولة الإسلامية في مواجهة النظريات العلمانية في التعبير والتطور وما إصراره العنيد على تطبيقها وإقامة الدولة الإسلامية على أساسها الاوعي تاريخي متفرد بدواعي إقامة الأمة الإسلامية الجديدة التي تنهض بمسؤوليات الريادة الوسطية في الجغرافيا السياسية والفكر والعلاقات الدولية ومناهضة الكفر العالمي واستئناف الحياة على أساس الإسلام.
من هنا أيضاً أدركت الأمة ان المشروع الخميني في التاريخ والفكر والقفز بالموروث الفقهي من خانة الجمود إلى خانة التطور والنمو والاستمرار هو المشروع القادر على قيادة الحياة وإثبات أحقية الشارع المقدس كما الشارع الاجتماعي في الاحتجاج والتمكين.
إن الإمام الخميني رضي الله عنه أراد من تأسيس الدولة القول بأن الأمة التي تتحرك بالإسلام لصياغة طروحتها السياسية قادرة على تجاوز النظريات المعادية التي
ـ(235)ـ
تقف في طريقها، ومثلما تمكنت الأمة في إيران من تجاوز قرون الاستبداد والكفر وسيطرة الغرب وتحدي آليات المشروع الغربي التخريبي بادرت بذات الوقت على إقامة (الدولة) وتنظيف مجالها النظرية والتطبيقي من آفات الإلحاق والتبعية، فعلى مستوى القيادة كان الإمام يقودها بجدارة الرمز، وكفاءة النظرية واقتدار الشعب، وعلى مستوى النظرية، كان الإسلام بموروثة الفقهي والسياسي والثوري والتاريخي يحرك الشارع ويلهب النفوس ويزكي المعادلة الثورية من مواطن السقوط والانهيار والتبعية وهكذا لبث الأمة كشرط تاريخي في الانقلاب السياسي والثوري والقيادة كشرط تاريخي الدفع والتسديد والتوجيه والعمل المتواصل الدور الأساس في إعادة الإسلام لواقع الحياة ومن هنا اختلف مع العنوان في مضمون فلسفة الخلود لأن ما يعنيني هو قابلية القيادة في تكريس الإسلام السليم والوصول بالأمة إلى شاطيء السلامة والأمان، وما أريد قولـه هو ان (القيادة) كامتداد للإمامة هي التي أعادت مفاهيم الإسلام إلى واقع الحياة رغم القدرة الداخلية التي يختزنها الفكر في الواقع التطبيقي للحياة وإلا لم لم تؤسس حكومة إسلامية مثل قيام الحكومة الإسلامية في إيران على يد الإمام الخميني ومن هنا يصح القول ان الرمز بفكره واقتداره كما الأمة هما أصحاب فكرة التخليد لأن المشروع الخميني هو صاحب المبادرة فيما يبقى الإسلام فكرة شرعية قابلة للتطبيق إذا لم تسنح لها فرصة الشرط التاريخي الممثل بالأمة المقتدرة والقيادة المتميزة.
الشرعية في مزايا العالمية
هنا سنعالج (عالمية) الشرعية مجوزين هذه المرة لأنفسنا الخوض في
ـ(236)ـ
(عالمية) الشرعية عبر التطرق للعالمية بوصفها الفرادة في امتياز موقفي الأمة والحاكم للوقوف الإجمالي أمام مسائل حديثة يفرضها سياق التحدي الذي تعيشه الأمة والنظرية السياسية في الراهن الداخلي والدولي ولكون الشرعية هي المدخل الطبيعي في قراءة فلسفة الإسلام ونظرته للوحدات التي يؤمن بها سياقه المدني.
فقد اختلف المسلمون في كيفية نصب الإمام واختيار الحاكم ـ الخليفة ـ لهذا المنصب الخطير وكانت المشكلة من الخطورة بحيث ماسل سيف في الإسلام إلا بسبب الإمامة بتعبير صاحب الملل والنحل الشهرستاني لكن الجميع متفق على ان الحاكم شرعيا إذ لم يتقيد بالتكاليف فيكون مقدار عمله تنفيذا أحكام الإسلام وإقامة العدل ورعاية الأمة وبالتالي توفير سبل أداء مسؤولية الاستخلاف.
ان المصدر الأول لشرعية كل حاكم في النظرية السياسية الإسلامية إنّما يستمد من قبوله الكامل الاحتكام إلى شرع الله بلا منازعه ولا رغبة في مشاركة ـ يقول الراغب في مفرداته (واعظم الكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة) وقال بن حزم (لا يحل الحكم إلا بما انزل الله تعالى عبر لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الحق وكل ما عدا ذلك فهو جور وظلم لا يحل الحكم به.
اذن النص الإسلامي كتابا وسنة هو الحاكم الأعلى والسلطة التي لا تعلوها سلطة.
ولاشك ان هناك من وقف إلى جانب مطاليب الأمة ودافع عنها بذهنه وسلوكه الفقهي كأبي حنيفة النعمان، عبر وقوفه كما تقول بعض الروايات إلى
ـ(237)ـ
جانب ثورة الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليه السلام ومحمد إبراهيم ابني عبد الله بن الحسن، وذكر أبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن عن أبي حنيفة (كان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور) ولذلك قال الاوزاعي: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف).
لكن الذي حصل ان جدار (الشرعية) تم توظيفه على أيد حكام الجور بالشكل الذي تحول إلى ثقافة نالت إلى درجة كبيرة من قيمة (الشرعية) التي رسمتها يد المشرع الإسلامي بأمانة مثلما ان المسحة المثالية التي اصطبغت بها صورة الحاكم في المقولات السياسية وقراءتها بشكل بعيد عن واقعيتها المفترضة جعلت منها مصدراً لتخريب علاقة الأمة بعناوين لصيقة (بالشرعية) كالدولة والقانون والعدالة وغيرها.
يشير الدكتور راشد الغنوشي في كتابه (الحريات العامة في الدولة الإسلامية) إلى ما يسميه الثغرة الكبيرة التي دخل منها الوهن، فهو يرى ان معظم كتب السياسة الشرعية ذات مسحة مثالية، ذلك لأنها حينما اشارت إلى مبدأ الخروج (الثورة) على الحاكم لم تأخذ بنظر الاعتبار التناسب بين الوسائل والغايات ولهذا السبب لم تجد لها طريقا إلى العمل وتوجيه التاريخ ويرى ان المعاني الكبرى في الجهاز الإسلامي كالبيعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشورى وأهل الحل والعقد وقوامة الأمة المستخلفة، ظلت غالبا معاني مجرد لاحظ لها من التطبيق لا بشكل جزئي ولا شكلي في كثير من الحيان وينتهى الغنوشي إلى تقرير النتيجة التي يريد الوصول إليها، حيث يقول (واحسب ان الفكر السياسي الإسلامي الحديث ولئن استمر تأثره بالمثالية الغالبة على السياسات القديمة فأن تصديه لمعالجة مشكلات الواقع وتقديم صيغ تنظيمه للقيم السياسية الإسلامية في
ـ(238)ـ
تنام رغم ان الانجذاب نحو القديم مازال سائداً وغالباً ما يشبه النكوص أحيانا، ولكن تيار التجديد في تنام واستئناف لمسيرته المباركة على خطى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وابن الخطاب وابن حزم وابن رشد وابن خلدون والأفغاني ومحمد عبدة وخير الدين التونسي وحسن البنا والترابي).
في هذا المقطع لم يصل الدكتور الغنوشي وهو الذي شخص داء السعي للارتفاع بمشكلات الفكر والممارسة في ان يذكر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان وضع افجع عوامل الارتفاع والاستئناف بحقوق الأمة، ولا ندري حقا السبب الذي يقف وراء احجام الغنوشي عن ذكر الإمام عليه السلام مع الذين ذكرهم.
الشرعية التي رسمها القرآن والسنة النبوية ومدرسة أهل البيت عليهم السلام بالفكر السياسي ـ الاجتماعي تارة وبالممارسة التطبيقية وتارة أخرى تعتبر إضافة إلى جميع التأكيدات والمقولات الفكرية الحديثة والقديمة من أهم القضايا ذات الصلة بالأمة وأسباب بقائها وحركة حضارتها وثقافتها السياسية والعقائدية والاجتماعية فبمقدار ما تقترب الأمة من شرط وعيها للإسلام وتكون قادرة على تشخيص مصالحها الذاتية بنفسها أو عبر نخبها وشرائح طبقاتها الواعية بمقدار ما تكون واعية أيضاً لصورة الحاكم ونموذج سلوكه وصورة الحكم وسلوكه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعقائدي والأخلاقي ولعل هذا الأمر (الوعي بالشرعية) كان من أولويات منهج أئمة أهل البيت عليهم السلام في الأمة عبر التوجيه والتثقيف تارة والنزول إلى الممارسة السياسية تارة أخرى وصولا بالأمة إلى مستوى حضاري وفقهي وسياسي تستطيع فيه تشخيص مصالحها باقتدار والسبب في ذلك ان (الشرعية) كانت من أهم أسباب النكوص الذي أصاب الدولة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل سياق الدولة غير قادر على كفاية المسؤولية
ـ(239)ـ
التي ألقيت على عاتقه وشكلت أزمة ثقافية ألقت بظلالها القاتمة على السلوك والحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الإسلامية وسبب كذلك إلى بروز الثورات والانتفاضات ودوامات الدم والمذابح التي شهدها التاريخ الإسلامي منذ بدايات القرن.
فالاستخدام السلبي لها وتوظيفها لأغراض سلطانية لها صلة بمآرب سياسية جاهلية تقف بالضد من إرادة التشريع والنظام الإسلامي وحقوق الأمة جعلها أكذوبة كبيرة طاعنة بالحقوق والإرادة والنظام، ولطالما استخدمت لأغراض تصفية أبناء الإسلام من رجال تفسير وفقه وصحابة وقطاعات كبيرة جوّعت ونفيت وقتلت للوصول إلى المآرب الكامنة بالاستيلاء على السلطة والتحكم بمقدرات المسلمين.
من هنا خاض الأئمة عليهم السلام أشرس المواجهات بمختلف اتجاهاتها وأساليبها الفكرية والجهادية من اجل تكريس الشرعية بمواصفاتها الإسلامية التشريعية التي تكريس في القرآن والسنة وخلافة الإمام علي عليه السلام حتى وصل الأمر ان يقدم الإمام الحسين عليه السلام حياته الشريفة من أجلها بوصفها الحاكمية التي تستعيد إرادة النظام السياسي وإرادة الأمة، واستئناف الحياة الإسلامية بجميع صورها وأشكالها بها، ولعل حكمة الثورة التي أسسها الإمام الحسين عليه السلام والقائلة (ما خرجت أشرا ولا بطرا وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) والإصلاح في معناه المعرفي هنا هو إعادة شرعية نظام الحكم بعد ان تلاعبت به الأموية وحولته إلى ملك وراثي عضوض تتقاذفه بأهوائها وشهواتها ومزاجها البعيد عن الإيمان والصدقية والإخلاص لهاذ الدين.
ـ(240)ـ
العبادات كشرط للنهضة والاستئناف:
وفرّ التشريع الإسلامي المقدّس مادة عبادية غنية ومتنوعة لها فلسفتها وفهمها الذاتي والاجتماعي الحضاري العام الذي يعكس واقعية الدين وقدرته على تربية ظاهرة إسلامية معتدلة وسطية.
وكل هدف العبادات ومازال منذ اليوم الأول من تشريعها تحصين شخصية الفرد والمجتمع الإسلامي من آفات التبعية للاخر والانحراف من سلوك الخط الإسلامي الرشيد وإنارة عقله لكي لا يشطح في دروب الظلالة والابتعاد عن خطى الهداية إلا ان الفلسفة الإسلامية التي قامت عليها (قيمة) العبادات تتمثل بوحدانية الله وتوحيد ومعرفة الاستئناس بخطابه وتأسيس مناخ إنساني يعرف الله تعالى ويؤدي تكاليفه بناء على موجبات هذه العبادات.
لكن الذي يتأمل بصورة العبادات ودوافعها وأشكالها يصل إلى تقرير عدة ما تنوعت واتخذت توليناتها كالصلاة والصوم والزكاة والحج إلا لأغراض لها علاقة بالتنوع والمعرفة التي جلبت عليه الذات وأشكالها إزاء بارئها العظيم.
نظام العبادات اذن كيان قائم بالمعرفة وعليها وليس حالة رمادية ليس لها قانون يضبطها أو أنها حالة سابحة في فضاء كنسي لا يسقط قيمة وأخلاقياته وعقديته على شخصية الإنسان المسلم وإلا لو كانت كذلك لما أطلق الفقهاء عليها وعلى سياقها في الحياة الإسلامية بـ (نظام العبادات) (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا).
لو كانت العبادات حالة مجردة من الإسقاط الفلسفي لما اجتهد التشريع وفقهاء الشريعة على أفراد حيز واسع من الأهمية والاهتمام بها ذلك ان الحالات
ـ(241)ـ
المجردة التي لا تتدخل في القضايا الكبيرة للمجتمع والدولة والحريات والسياسة تبقى حالات ليس لها هامش من المعرفة ولاتتم العناية بها قدر العناية بالمسائل التفصيلية الملحة.
العبادات وحدة عقائدية أساسية والوحدة بلغة التشريع الرباني نظام قائم بذاته لـه قوانينه وشروطه وانفعالاته في النفس البشرية وقادر بفعل طاقته الحرارية التي يختزنها في داخله إثارة القوة الروحية في الشخصية الإسلامية المتعبدة (وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون).
هنا بودنا ان نسرح قليلا في الظلال الروحية التي تثيرها العبادات لكن وقبل ان نذهب في هذا القليل من هامش الظلال يجب القول ان العبادات وسيلة ربانية لتحقيق أهداف العبودية لله تعالى وحين تكون كذلك يتوجب على المجتمع الإسلامي ان يمارسها لا باعتبارها (واجبات مفروضة) بل واجبات للاقتراب من حقيقة التشريع المطلقة والمعرفة والتزود الواعي من معين الروح المقدس لأن لكل مجتمع حضاري هوية يختص بها وأطروحة روحية يستهدي بها في دروب العمل في آفاق الحياة وبذلك رسم التشريع الإسلامي ملامح العبادات وظلالها المختلفة لتكون هوية المجتمع والقوة الروحية في الانطلاق لوعي ذاته وكينونته البشرية.
من ظلال العبادات مسألة الصلاة التي أعتبرها الفكر الإسلامي (سنام الدين) و(عمود الدين) ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها) وما يهمنا هو ربط هذه العبادات بقبولها فليس المفروض من تشريعها أداءها الميكانيكي بل يتحدث التشريع بلغة يريد من خلالها قيام وحدة شعورية ومعرفية خاصة بين النفس والصلاة وإلا تنتفي الضرورة لقيامها ان هذه التفاعل يحدث من خلال حركة
ـ(242)ـ
النفس البشرية التواقة إلى المعرفة باتجاه بارئها في خط تتكثف في دائرته كل المكونات العقلية والمعرفية والاستيعاب الشمولي لعناوين الفكر والممارسة والدعوة والشريعة وإلا إذا كانت فريضة الصلاة هي بهذا الجزء المتعلق بواجبها لما شرعها البارئ عز وجل وربطها بقيام الإسلام كدين في الحياة البشرية.
الحج يكاد يكون مشروع طموح باستعادة نموذج الدولة الإسلامية في العقل وفي التاريخ حيث يلتقي الملايين من أبناء الشعوب الإسلامية في مكة المكرمة ليؤدي مناسك هي في شكلها الخارجي ومضمون فلسفتها الداخلية تعبيرا عن مشروع حضاري رائد في مقاومة التجزئة والتبعية والانحلال في خطوط الحضارات المادية الراهنة وهكذا تندرج جميع العبادات في خط لـه علاقة بالعقل والوعي وقدرته على الانفتاح كما لديه القدرة على ربط الشخصية الإسلامية بطموحاته وآمالها في الحياة.
ما يمكن قولـه في هذا المجال ان تشريع العبادات لـه طابع نهضوي في مسار الأمة وعمق شخصيتها الإسلامية الرسالية يستنهض همة الشخصية ويحفزها للفعل الحقيقي القادر على حمل رسالة الإسلام وإيصالها إلى أهدافها التي تصب في قلب الحضارة.
الخلاصة:
يتميز الفكر الإسلامي عن غيره من المدارس والأديان بمرونة وواقعية أهلته إلى قيادة الحياة وتشكيل الدولة على لوحة الواقع الاجتماعي ـ الإنساني.
وحين يتسع هذا الفكر بما أوتى من تشريع لأفاق الحياة، فانه من البديهي ان يتسع لتحولات التطور الثقافي والفقهي المطلبي، ويكون الصورة. الشرعية التي
ـ(243)ـ
تقف وراء المذاهب السياسية والاجتماعية والأخلاقية التي تنتمي للدين، وعلى هذا الأساس شكل الفكر وقراءاته للحياة (المشترك) الذي تلتقي في ساحته جميع هذه المذاهب إذ مادام التشريع الصورة الكاشفة لمطلق الغيب ورأيه بعوالم الشهادة، فأن اجتهادات المذاهب ستكون حالة تفيد من التشريع ولا تنفيه، يجتهد في إطاره ولا تخرج عليه تبدع في نظره ومعرفته وتحولاته في المجتمع وحركة التاريخ ولاتدعي في فلسفته ورأيه.
نحن أمام دين كاشف للنفس والمعرفة، ونظرية قادرة على تمثيل حركة الوحي بأبعادها البشرية في الواقع، وما دام هذا الكشف يصب في خدمة التلاقح والمعرفة والوعي، فأن كل وحدة من وحدات هذا الدين، هي نظام كوني بحد ذاته يعطي للفكر صورته الدقيقة، ويفرد للامة (دورها) المعتدل الوسيط، ويأخذ بسياق تجربتها إلى قلب الحضارة، مما يعني ان الكونية هي الرديف الأساس لمعنى وحداته سواء في القضاء والقانون والسياسة أو في التحذيرات والتعزيرات الداخلية والخارجية.
ان كل وحدة من وحدات النظام الإسلامي تعبر عن ذات الوحدة التشريعية الداخلية وليست حالة مضغوطة في اطارها أو وافدة عليها كما في المدارس الفكرية الأخرى، ومن هنا تعددت اتجاهات النظر لهذه الوحدات حسب مرونة وواقعية المشروع الإسلامي، واختلفت الصياغات النهائية لسقف هذه الوحدات الأمر الذي حول صورة النظرية الخارجية إلى مظهر لعالميتها فيما تكرست صورتها الداخلية عميقا في ألواح الخلود الإنساني.
ما يعنينا هنا ان التعددية في النظر لهذا الدين راكمت المدرسة الإسلامية وتجربتها في الاجتهاد الإنساني بحيث تحول الفقه الجنائي أو الاجتماعي أو
ـ(244)ـ
السياسي أو القضائي من إطار سياقه التقليدي الاشتغالي الداخلي إلى حركة الحياة الممتلئة بالحيوية والقوة والاستمرار، وهذا الأمر يندرج على لك الأشكال والتمظهرات الفكرية والفلسفية الإسلامية على هاذ التعدد ينبغي ان يبقى في إطار إغناء المادة الاجتماعية المرتبطة بهموم الاستئناف ولا ينسحب إلى دوائر الخلاف والنكوص والانغلاق، إذا أخذنا بالاعتبار ان مرونة والواقعية هي أهم مزايا حضارية هذا الدين وقيمومته على الحياة ومثلما تفرض الضرورة الاجتهاد في الداخل، تفرض بذات الوقت العناية بالعناوين الفكرية التي لها مسيس علاقة بيوميات المجتمع الإسلامي وهو يتطلع لصياغة أهدافه في الحياة من خلال الإسلام ومن هذه العناوين (الشرعية) وتلازمها مع نظام القيادة المسؤولة عن تشريع القوانين وإدارة الحياة السياسية يأتي عبر تلازم مسار الدولة الإسلامية مع الآخر في تحولات فكره وثقافته.
نحن بأمس الحاجة لأبعاد الأمة عن مواطن الشبهة بالإسلام من خلال قراءته من الداخل والكشف عن معدن مفاهيمه وفلسفته وكشف قدرته على مماحكة الآخر في فكره وفلسفته وعناوينه، ومن دون هذا الكشف فأن مرجعية الإسلام التشريعية إضافة إلى وحداته ستتعرض إلى تحديات من نوع جديد خارج سياقات الفعل الاستعماري والمشروع الغربي وتحدياته لاننا سنكون وجها لوجه مع الأمة التي تريد ان تعرف رأي المشروع الإسلامي بمجمل المماحكات التي تعترض شخصيتها وهويتها وهي عناوين لدى الإسلام رأيه الخاص بها.
ان الإسلام كدين وكمشروع حضاري في الحياة الاجتماعية لا ينبغي ان يجتهد على أساس تجميد (دوره) في الحياة مقابل الأدوار المتحركة في سياقات المذاهب والمدارس السياسية الأخرى التي وظف الاجتهاد وأبعاده في مدارسها
ـ(245)ـ
على أساس (التوسع) و(الإمامة الكونية على العالم).
ينبغي ان تتحرك عملية الاجتهاد على أساس دفع المشروع إلى حيز الدوائر الحقيقية في العالم تلك الدوائر التي تمثل أساس وظيفته في الحياة وإلا إذا تم تجميد المشروع في مواقع استنباط أحكام العبادات والمعاملات الاجتماعية التي لا تتعدى براءة الذمة في النظر لأحكام الإسلام، فأن المشروع الإسلامي سيخسر (دوره) في المعركة الراهنة في دورة التاريخ الراهن لفرض (إمامة الغرب) قبالة (إمامة المشروع الإسلامي) ولا تنتهي هذه المعركة إلا بانتصار أحد الطرفين وفق سنن التاريخ.
فهل سنبقى نناقش المشروع الإسلامي بذهنية (أحكام الطهارة والنجاسة) أم نقفز على وقاع هذه المنهج إلى مناقشة تحديات الآخر عبر تطهير المنهج من نجاسة الغلو وطهارة التفريط.

